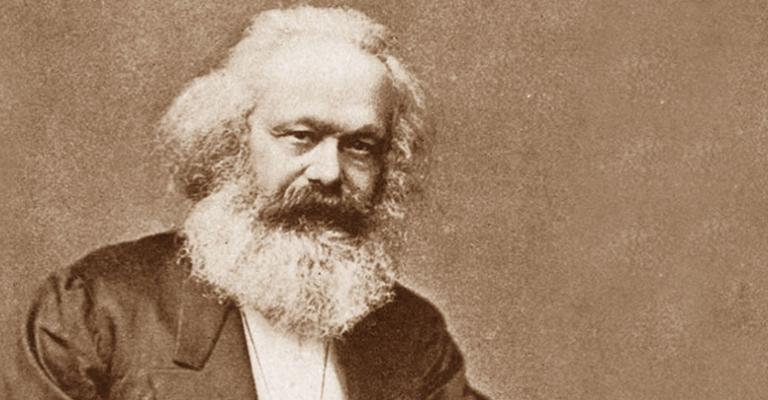النقد الفلسفي لخطاب الاستحواذ اللاهوتي

أراد سبينوزا أنْ تتقدّم الفلسفة بتفسيرات عملية لتحرير المعرفة العقلانية من مقدمات التقديس والتصورات الزائفة والأفكار القبْلية المفترضة سلفاً. وكانت محاولته نابعة من إدراكه العميق لمشكلات عصره الفلسفية، ولاسيما في طرائق الفهم، ومناهج التحليل، وأساليب التفكير. ونظرَ، دائماً، إلى مشكلة المعرفة على أنها مشكلة العقل نفسه في مواجهة الطريقة اللاهوتية السلفية، لذلك شرعَ منذ البداية بتأليف رسالة في العام 1661 حول هذه المشكلة أسماها: رسالة في إصلاح العقل، متأثراً بفلسفة ديكارت العقلانية الشاكة بهذه المقدمات والتصورات السلفية المطلقة والدوغمائية، إذ دفعه ذلك بصورة أوسع إلى تخصيص كتاب حول الفلسفة الديكارتية نشره في العام 1663 بعنوان: مبادئ فلسفة ديكارت.
وبعد تزايد النظريات المعاصرة التي تعمل باستمرار على تحويل مفهوم النصّ من مفهوم خاص يتحكم به جنس الكتابة، ويضفي عليه خصائص نوعية، إلى مفهوم عام يجمع في ذاته طائفة من الخصائص النصّية وغير النصية التي تسمو على النوع نفسه. فقد أصبح من الضروري العودة إلى الروح النقدية لسبينوزا، تلك الروح المفعمة بالتطلع إلى فَهْم النصوص المشحونة بإيديولوجيا موطِئة للاستحواذ وتفكيكها من خلال التطور العقلاني للمعرفة. واختباره عملياً عبر استعمال طرائق نقدية وشكية وعقلانية في تحليل المقولات الفلسفية، أو في محاولة فهم النص المقدّس وتفسيره بعيداً عن الوقوع في دائرة السحر الإيديولوجي المقدس.
أطاح سبينوزا بالطريقة الفيلولوجية التي احتكرت إلى حدّ بعيد عملية النظر في النصوص المقدسة. واستناداً إلى طريقته في الفهم، أصبح النصّ المقدّس نصاً ثقافياً بامتياز؛ بمعنى امتصاصه للخزين الثقافيّ الفرديّ. وهذا ما يقتضي رؤية جديدة في الإدراك والتأويل، وهي الرؤية التي اقترحَها بدلاً من التأويل الذي كان سائداً حينئذٍ في تفسير النصّ المقدّس، وهو بذلك يستثمر نموّ النزعة الفردية التي كرّسها خطاب النهضة الأوروبية، ويستثمر كذلك الأرضية الفكرية التي أشاعتها قبله عقلانية ديكارت. وأفكاره عموماً تنصبّ في محاولة تعديل مفهومَيْ: النصّ والتأويل، وهو يعمل على تخليص النصّ من تزييف الذات المؤوِّلة في الخطابات الاستحواذية، وتخليص التأويل من القَبْلِيّـات أو الفرضيات المسبقة، والموجّهات الإيديولوجية، وهو يلحّ على هذه الفكرة في أكثر من موضع من مؤلفاته.
وتندرج كلّ أفكاره في إطار صراع عنيف بين المعرفة في إطار العقل، المعرفة في إطار الخرافة التي هي نسق من الأوهام والتصورات الإيديولوجية غايتها فرْض السيطرة والاستحواذ. ويترتّب على اختيار المعرفة في إطار العقل، وإقصاء المعرفة في إطار الخرافة تكوين فَهْم للنصّ أكثر عمقاً، وأكثر إحاطة بتساؤلاته وقيمته التاريخية. وإنّ طغيان الإطار الثاني في عملية التأويل سوف يفضي إلى إفساد مفهوم النصّ برمته. ولأول مرة في تاريخ الفكر الغربيّ، يؤسس سبينوزا نظرية معرفة تتجاوز تلك التي كانت تُعنى في المقام الأول بتتبع صحة النصوص ودقة نسبتها، وتكوين معرفة فيلولوجية تقوم على التفسير اللغوي والبلاغي، والتأكد من صحة النصّ عبر تحقيق مادته الفكرية؛ أي ما يسمّى اليوم: علم التحقيق.
وعلى هذا الأساس، انصبّ عمل سبينوزا على تكوين معرفة نقدية لتفاسير الكتاب المقدّس وتأويلاته وشروحه الفيلولوجية وما دار فيها من جدل حاد بين تيارين من المفسرين: الأول، يعتمد التفسير المجازيّ التأويلي، والثاني، يعتمد التفسير الحرفيّ، وهو يوضح أنّ هناك من يرى أنه لا ينبغي تفسير أيّة فقرة من الكتاب تفسيراً مجازياً بدعوى أنّ المعنى الحرفيّ مناقض للعقل، بل إنّ هذا التفسير لا يجوز إلا حين يتناقض هذا المعنى مع الكتاب ذاته؛ أي مع العقائد التي يدعو إليها بوضوح. وهكذا صاغ هذه القاعدة الشاملة: كل ما يدعو إليه الكتاب بطريقة قطعية، وينصّ عليه بألفاظ صريحة، يجب قبوله على أنه حق مطلق، اعتماداً على سلطة الكتاب وحدها[2] .
انصبّ عمل سبينوزا على تكوين معرفة نقدية لتفاسير الكتاب المقدّس وتأويلاته وشروحه الفيلولوجية
وينتقد سبينوزا اتخاذ اللاهوتيين التأويل المفتوح والتعسفي طريقةً لحمْل النص المقدس على النطق بتصوراتهم المشحونة بأوهام وخرافات زائفة تخدم توجهاتهم الإيديولوجية. ولتحقيق هذه الغاية لجأوا إلى التفسير المجازيّ الذي يمكنهم من تضمين النصّ ما يرغبون في تضمينه من أفكار استحواذية. فبنية المجاز ذات مرونة تمكّنهم من تحويل صور المجاز إلى فيض من التفسيرات والتأويلات الكلامية الجدلية. وهذه هي الفجوة التي يتسلّل منها شيطان الغائية الإيديولوجية. فالمجازات تتمتّع بإمكانية تحفيز الأفكار الغائية الرابضة في أعماقنا. ومع أنه كان يدعو إلى الأخذ بنظر الاعتبار المعنى الحرفيّ للنص المقدّس، إلا أنّ حقيقة فلسفته كانت قائمة على تكوين جدل عقلانيّ حتى مع المعنى الحرفيّ. وهو يؤسس نمطاً من المعرفة تحاول إضعاف التأويلات المتعالية وإضعاف نشاطها الميتافيزيقي المعيق لتطور المعرفة والعلم والعقل.
لقد انصبت فلسفة سبينوزا على تأسيس خطاب نقديّ للتفاسير اللاهوتية، واتصف بصلابة أفكاره وجرأتها في تأسيس فلسفة عقلانية ونقدية لتفاسير العهد القديم، لأنها لم تتحرّر من دوغمائية التفسير الإيديولوجي. فهو ينتقد ذلك التفسير اللاهوتي الذي ينطلق من مقدمات محددة سلفاً، إذْ إنّ النص المقدس في نظر اللاهوتيين له معنى غامض وخفي، لا يمكننا الكشف عنه إلا بإشراقة فوطبيعية[3]، ولا يختلف اللاهوتيون في كل الأديان حول هذه الإشراقة الفوطبيعية. وهنا يكمن التعارض بين الطريقة التي يريد أنْ يسلكها اللاهوتيون لتمرير رسائلهم الإيديولوجية المغلّفة بمؤثرات الهيمنة، وبين سبينوزا الذي اكتشف تلك الطريقة المخادعة للهيمنة. ولذلك يمكن تفسير محاولاته على أنها مسعى لتكوين معايير عقلانية للفهم يزعزعُ المعايير الزائفة للمعرفة اللاهوتية. وهكذا فُسِّرتْ تلك المحاولات على أنها موقف ثوريّ للوقوف بوجه اللاهوتيين السلفيين وفكرهم وطرائقهم في تفسير الكتاب وتفسير التاريخ. فقد كان هؤلاء ينهلون من تراث دينيّ غني ومقولات سلفية ذات تأثير روحيّ متوارث تعمل باستمرار على توطيد أركان السلطة الدينية والهيمنة الروحية، وتقوية نفوذها كسلطة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير. وقد جاء سبينوزا فقلب لهم المعايير رأساً على عقب، فطاردوه شرّ مطاردة، وضيّقوا عليه ونفوه وحرموه من ميراثه وكفّروه ومنعوا تداول مؤلفاته. وكان ينعت معرفتهم بأنها لا تنتمي في شيء إلى الإيمان ولا إلى الدين الـمُوحَى به.
ونظراً لتماديهم في التمسّك بطرائق المعرفة السلفية الموروثة، والمنطلقات النظرية القبْلية، فقد أخذ سبينوزا على عاتقه مهمة تشذيب العقيدة الدينية وتخليصها مما ألحقه بها التحريف والدوغمائية. وتوصّل عبر مشروعه الفلسفي إلى استنتاج حقّ كل فرد بحرية التفكير والفَهْم[4]. فحرية التفكير في قراءة النصّ، هي التي تفضي بنا إلى قداسة الكتاب، لا سلطة القداسة المفترضة سلفاً لأننا سنكون أكثر حرية بمقدار ما نفعل بتوجيه العقل، ونكون أكثر عبودية بقدر ما ينجم سلوكنا عن أهواء النفس، لأننا بمقدار ما نفعل بتوجيه من العقل، ننـزع نحو كمال طبيعة طبيعتنا وعلى العكس من ذلك كلما كان سلوكنا ناجماً عن أهواء النفس كلما ازداد عبودية لقوة الأشياء الخارجية[5]. ويجب أنْ نفطن إلى أنه قد وقف موقفاً فلسفياً عقلانياً لمراجعة العديد من المفاهيم الآنفة كحقّ الفرد بحرية التفكير، والعقل، وأهواء النفس.
وكان كتابه: الأخلاق، دراسة فلسفية تجمع من الناحية المنهجية صرامة المنطق والرؤية الفلسفية العقلانقدية لمراجعة مفاهيم تمّ تداولها في الفلسفة الكلاسيكية، مثل الله والجوهر والعرض والنفس والانفعالات والعقل وحرية الإنسان وسوى ذلك من مفاهيم. وكان يسلكُ منهجَ المناطقة والرياضيين في: الحدود والتعريفات، ثم الشروحات، ثم البدهيات، ثم البراهين.
إنّ عناصر خطاب الاستحواذ وآلياته عند سبينوزا على نحو ما تمثلتْ لدى اللاهوتيين هي:
1- المؤلف: وهو الذات الإلهية المقدسّة.
2- النصّ: وهو الكتاب المقدّس.
3- المتلقي العادي: ويتمثل في جمهور المؤمنين.
4- الشارح الوسيط: وهو الـمُوؤِّل المشبع بالفكر اللاهوتي الذي يعطي للتأويل أبعاداً إيديولوجية عادةً، فممارسة التأويل عنده هي ممارسة عملية وغائية.
5- القارئ النقدي: ويتمثل في نخبة الفلاسفة العقلانيين الذين يفككون شفرات الزيف في خطاب الاستحواذ.
6- القارئ الضمني: وهو القارئ الجوهر الذي يخاطبه الكتاب المقدّس خطاباً روحياً خالياً من الغايات والأغراض الإيديولوجية.
ولأنّ ثمة علاقة وثيقة بين الاستحواذ والفَهْم؛ فإنّ سبينوزا حاول تأسيس علم تفسير قائم على الإدراك العقليّ العميق للنص المقدّس، لأنه كان يعرف مدى خطورة التأويل اللاهوتي الذي تختلقه العقول الهزيلة والنفوس التي تحركها الأهواء والخرافات والغايات الإيديولوجية الصرفة. ولذلك، انصبّ جهده الفلسفيّ على تأسيس أعراف لهذا النوع من الوعي والإدراك الذي يقوم على معايير محددة تتوسط بين النص ومتلقيه:
- تخليص الفهم والتأويل من الوقوع تحت تأثير الفَهْم القَبْليّ والوقوع تحت تأثير الـمُسَلَّمات والنيّات الغائية. ومن يقرأ كتابه: رسالة في اللاهوت والسياسة الذي يشكّل جوهر أطروحته الفلسفية، سوف يكتشف ضجره المستمرّ من هذه المشكلة التي تعيق رؤية النصّ بوضوح كامل. يقول: إننا نرى معظم اللاهوتيين وقد انشغلوا بالبحث عن وسيلة لاستخلاص بِدَعِهم الخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة بتأويلها قسراً، وبتبرير هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية، وهم لا يكونون أقلّ حرصاً وأكثر جرأة في أيّ موضع آخر، بقدر ما يكونون في تفسير الكتاب، أيّ تفسير فكر الروح القدس. والأمر الوحيد الذي يخشونه، ليس الخوف من أنْ ينسبوا إلى الروح القدس عقيدة باطلة أو أنْ يحيدوا عن طريق الخلاص، بل أنْ يقنعهم الآخرون بخطئهم، وأنْ يروا أعداءهم وقد قضوا على سلطتهم، وأنْ يكونوا موضع احتقار الآخرين[6].
وعبر هذه الطريق التي سلكها سبينوزا لتقويض سلطة احتكار المعرفة والتأويل عند اللاهوتيين، وجد أنّ مواصلة طريق العقلانية يقتضي أولاً تفكيك النسق الإيديولوجي في الفكر اللاهوتي وكَشْف زيفه بانشغاله بتأويل مجازات النصّ المقدّس واستعاراته أكثر من انشغاله بطرق المعرفة الحقيقية. وقد أثارتْ نظريته، في أنّ الله ماثل في الكون والطبيعة زوبعةً من ردود الأفعال من قبل رجال الدين اليهود في أمستردام. لكنه واصل طريقه بعناد مفترضاً أنّ البلاغة المقدسة لا يمكن التعسف في تأويلها تأويلاً غائياً وصرْف النظر عن كونها صوراً لتجسيم المعنى ولمخاطبة الروح. ووجد هؤلاء في أفكاره تحريضاً ضد سلطتهم المطلقة في احتكار تأويل الكتاب ووضْع تشريعاته في الهيمنة الروحية على جمهور المؤمنين به وتحويلهم إلى جماعة إيديولوجية من خلال ممارسة بيداغوجية صارمة منغلقة على منظومة فكرية وأخلاقية سلفية، وهو فعلاً كان يعمد إلى التحريض عبر مناقشة عقلانية تتوسل بالحجج والبراهين أسلوباً للإقناع. ويطالب باستبعاد كل ما هو خارج المعرفة العقلانية: كل ما يوجد في الطبيعة ونرى أنه شرّ، أعني كل ما نعتبره قادراً على منعنا من البقاء والتمتع بحياة موافقة للعقل، إنما يحقّ لنا استبعاده بالطريقة التي تبدو لنا الأوكد[7].
ويجد علة لذلك بأنّ: الإنسان الذي يهتدي بالعقل لا ينقاد إلى الطاعة بوازع الخوف.
ويُقرِن هذا بالحرية الإنسانية على نحو مباشر، فيقول: يكون الإنسان الذي يهتدي بالعقل أكثر حرية في دولة يعيش فيها في ظل القانون العام، منه في العزلة حيث لا يصدع إلا بأمر نفسه[8].
- تخليص النصّ من (التأويل الـمُدَنِّـس) الذي هو تحريف النصوص لتصبح عقيدة إيديولوجية لم يدعُ إليها الكتاب أصلاً. يقول: لو كان الناس صادقين في شهاداتهم بصحة الكتاب لكان لهم أسلوب في الحياة مختلف كلّ الاختلاف، ولما اضطربت نفوسهم بكلّ هذه المنازعات، ولما تصارعوا بمثل هذه الكراهية، ولما تملكتهم هذه الرغبة العمياء الهوجاء في تفسير الكتاب وكشف البدع في الدين، بل لما تجرَّؤوا على أنْ يؤمنوا برأي لم يدع إليه الكتاب بوضوح تام على أنه عقيدة في الكتاب، وأخيراً لامتنع مدنّسو المقدسات، الذين لم يتورعوا عن تحريف الكتاب في مواطن كثيرة عن ارتكاب مثل هذا الجرم ولما وضعوا عليه أيديهم الدنسة[9].
- تخليص التأويل من سلطة الخرافة ومن المضامين الميثولوجية بوصفها آليات للسيطرة والاستحواذ على المجتمع ذهنياً وروحياً ونفسياً ومادياً. وفكرة سبينوزا أنْ لا يكون التأويل مُسَخَّراً في خدمة الإيديولوجيا الـمُضَمَّنة في الشروح والتأويلات اللاهوتية للكتاب المقدّس وتسخيره لخدمة أهداف سياسية. فهو يرى أنّ الخرافة شرّ من الشرور التي تدعو إلى احتقار الطبيعة والعقل، وإلى الإعجاب بما يناقضهما وتعظيمه، ومن هنا لم يكن مما يدعو للدهشة أنْ يعمل الناس، من أجل زيادة تعظيم الكتاب واحترامه على تفسيره، حيث يبدو متناقضاً إلى أكبر حدّ ممكن مع هذه الطبيعة نفسها ومع هذا العقل ذاته[10]. ويذهب إلى أنّ التفكير الخرافي: يسلّم بأنّ الخير هو ما يجلب الحزن، والشرّ هو ما يتسبب في الفرح[11].
وتقوم نظرية سبينوزا على تشخيص نمطين رئيسين للتأويل، كانا سائدين في عصره، وهما:
- التأويل الذهني الخالص، وهو الذي ينجزه قرّاء يدافعون بالذهن والعقل وحده عن كلّ ما يدركونه بالذهن الخالص[12]، وهو هنا يشير إلى نظرية موسى بن ميمون (1135-1204م) في كتابه: دلالة الحائرين، ويرفضها[13]. وكانت فلسفة هذا الفيلسوف القرطبي الأندلسيّ تقوم على تفسير الكتاب بالعقل أي بمبادئ خارجية عنه، وذلك لأنّ "الأسرار" والمعجزات والإيمان والوحي كلّ ذلك ليس غريباً على العقل الصحيح[14].
- التأويل الانفعالي، وهو الذي ينجزه قرّاء يدافعون بانفعالاتهم عن المعتقدات اللاعقلية التي تفرضها عليهم انفعالات النفس[15]. فخصص في كتابه: علم الأخلاق، مساحة كبيرة للحديث عن طبيعة النفس وأصلها وأهوائها وانفعالاتها.
وللخروج من هذا المأزق المعرفي، والتحرر من هيمنة أحكام اللاهوتيين المسبقة، فإنه يقترح طريقة للتأويل تستند إلى معايير المنهج العقلاني الذي يفيد من منهج تفسير الطبيعة، ولذا بوسعنا أنْ نسمّي تأويله بـــ: التأويل الطبيعقلاني الذي يحرص على تكوين معرفة تاريخية عن طريق جمع المعطيات اليقينية الصحيحة، يقول شارحاً هذا المنهج: حتى لا نؤمن في غفلة منّا ببدع من وضْع البشر، وكأنها تعاليم إلهية، يجب أنْ نتحدث عن المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه لتفسير الكتاب، وأنْ يكون تصورنا له واضحاً، فطالما كنا نجهله لن نستطيع أنْ نعلم شيئاً يقينياً عن تعاليم الكتاب أو الروح القدس. ولكي لا أطيل الحديث ألخّص هذا المنهج، فأقول: إنه لا يختلف في شيء عن المنهج الذي نتبعه في تفسير الطبيعة، بل يتفق معه في جميع جوانبه، فكما أنّ منهج تفسير الطبيعة يقوم أساساً وقبل كلّ شيء على ملاحظة الطبيعة، وجمع المعطيات اليقينية، ثم الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الطبيعية، فكذلك يتحتم علينا في تفسير الكتاب أنْ نحصل على معرفة تاريخية مضبوطة، وبعد الحصول عليها؛ أي على معطيات ومبادئ يقينية، يمكننا أنْ ننتهي من ذلك إلى استنتاج مشروع لفكر مؤلّفِي الكتاب. وعلى هذا النحو، أعني إذا لم نسلم بمبادئ وبمعطيات لتفسير الكتاب ولتوضيح محتواه إلا ما يمكن استخلاصه من الكتاب نفسه ومن تاريخه النقدي - يستطيع كل فرد أنْ يتقدم (في بحثه) دون التعرّض للوقوع في الخطأ، كما يستطيع أنْ يكوّن فكرة عما يتجاوز حدود فهمنا، يكون لها نفس اليقين الذي لدينا عما نعرفه بالنور الطبيعي[16].
يعد سبينوزا أحد الفلاسفة القلائل الذين أثاروا بحث قضية تأويل الكتاب المقدس في منتصف القرن السابع عشر
ويعد سبينوزا أحد الفلاسفة القلائل الذين أثاروا بحث قضية تأويل الكتاب المقدس في منتصف القرن السابع عشر، بيد أنّ إثارته كانت موسومة بهاجس تغليب المنطلقات القدسية على المنطلقات الموضوعية، مما يعمل شيئاً فشيئاً على قَتْل المقدرة النقدية في العقل التحليلي. وتتميز محاولة سبينوزا في مناقشة التفسير اللاهوتي بإخراجه عن التفسير الأفقي الذي يوصل النص بالقارئ أي بالاعتماد على الكتاب وحده أو العقل وحده.
وإذا كان سبينوزا قد سار بهذا الاتجاه النقدي، فإنه من جانب آخر قد ثار على الطريقة اللاهوتية التي كانت تضع معايير خارجية للتأويل لتوظيف قدرة الأسطورة البلاغية والغرائبية، التي تناسب فكرة الإعجاز، على تحقيق الاستحواذ المطلق. وحديثنا هنا يجري على التأويل السبينوزي بوصفه منهجاً يتصل بضرب من التصور الإنساني تجاه المقروء، هذا التصور يتجاوز عقدة أنْ يكون المتلقي خاضعاً لسلطة استحواذية ترسم حدود الفهم والإدراك وتضع أمام العقل إشارات قدسية لا يمكن تخطّيها.
إنّ التأويل في فكر سبينوزا هو تأويل العقل الذي يمتلك خصوصية إشاراته التي يستطيع من خلالها أنْ يكشف عن مخبوء النص الذي يدعم حقيقة وجوده، وإخراجه من التصور اللاهوتي فقط، إلى أفق أكثر شمولية يدمج النصّ بالمعرفة العقلانية والتاريخانية. وإذا كان تأويل سبينوزا يتعلق بإثبات قداسة الكتاب من خلاله، ومن خلال العقل، ومنهج التفسير الطبيعي، فإن هذه المنهجية قد أوجدت تقارباً بين تأويله والتأويل البنيوي على النحو الذي تطرّقَ إليه تودوروف، وعلى النحو الذي بيّنه ألتوسير الذي يرى أنَّ سبينوزا أول من طرح مسألة القراءة/التأويل. فالفكر السبينوزي في نقده تفاسير الكتاب المقدس كان يتحرّر من الطريقة المتواترة في العقل اللاهوتي وطريقته في التأويل على نحو يفضي إلى إطلاق الكتاب المقدس في فضاء أسطوري لا نهاية له. ولذلك، فهو يقول: يجب ألا نفترض أنّ كل ما يقال إنّ الله قد قاله لأحد في الكتاب المقدس هو نبوءة أو كشف[17]. ففي الفكر الغربي ثمة صراع امتاز بطابع عنيف بين التأويل المسيحي وتيار التأويل العقلاني في الفلسفة اليونانية. وقد اتسم ذلك النزاع بنتائج مثيرة في تاريخ الغرب عقيدة وفكراً. فقد شهد الدين المسيحي ما كان يعرف بـ (الهرطقة) التي ليست سوى نمط من أنماط التأويل المفتوح المتناقض مع مبادئ العقل، فهو محض آراء مبنية على الاجتهاد الشخصي في التشريعات المسيحية.
وشهدت الفلسفة نفسها انقساماً حاداً في طبيعة التفكير الفلسفي، ما بين مفلسف للعقائد الدينية المسيحية، ومعارض لكثير من فرضيات وأفكار المسيحية الأساسية كما يتجلى في اعتبار المسيحية أنّ العالم مخلوق من عدم وأنّ التجسيد الإلهي في المسيح يستند إلى مشروعية إيمانية في المقام الأول، وقد أحدث هذا التجسيد تغيراً انقطاعياً في مسار الكون والزمن معاً[18]. وبما أنّ الشق الذي انتصر وساد من المسيحية هو ذاك الذي يقول بألوهية المسيح، فإنّ فعل التجسّد يعادل خرقاً للثبات الإلهي والكوني معاً. وهذا بالتحديد ما كان يشقّ كل المشقة على ورثة الفلسفة اليونانية أنْ يقبلوه. وقد تصدى قلسوس الأبيقوري في القرن الثاني الميلادي في كتابه: البيان الحق لنقد المسيحية في تلك المعتقدات ذاتها[19].
إنَّ موقف سبينوزا من رجال اللاهوت قد خلقَ علاقةً لم يكن الصفاء والتوافق يحكمها، لأنه كان موقفاً بلور رؤية نقدية وتفكيكية لخطاباتهم، فهم يُخضعون النصوص لتأوّلاتهم التعسفية وتصوراتهم الغائية والقَبْلية وينطلقون من المجاز المقدس بوصفه مرتكزاً للتأويل ويجعلونه مبدأ للتفسير والتأويل التعسّفي، وهذا ما يتعارض مع رؤيته النقدية، فهو يدعو إلى استخلاص هذه النتيجة إذا أمكن استخلاصها كنتيجة وليس كمقدمة في نهاية عملية البحث والتأويل بعد التفكير الكامل فيه تاريخياً وعقلياً.
إنّ مشروعه القائم على تبديد الأسطورة الدينية للتأويل، قائم في الوقت نفسه على الرؤية، التي، كما يرى ألتوسير، تفقد عندئذ امتيازاتها الدينية بما هي قراءة مقدسة. إنها لا تعود إلا ارتداداً فكرياً للضرورة المتضمنة التي تربط الموضوع والمسألة بشروط وجودها المتعلقة بشروط إنتاجها. وإنّ هذه الرؤية السبينوزية شقّتْ طريقاً لا يمكن إغلاقُه في التأويل العقلاني، ونصبتْ مصابيح كاشفة في ابستيمولوجيا تفكيك خطاب الاستحواذ. لذلك، استضاء ألتوسير بتلك المصابيح في قراءته لرأس المال، محاولاً أنْ يقوم بقراءة فلسفة كارل ماركس على نحو يكشف عن الوشائج المرجعية بفلسفة هيغل، لكنها وشائج ليست متوافقة على طول الخط لما بين الفلسفتين من حدود للتمايز الابستيمولوجي والإيديولوجي يُلمح إليه ألتوسير: "لابد من الانفصال عن الأسطورة الدينية للقراءة. هذه الضرورة النظرية قد اتخذت لدى ماركس صورة دقيقة هي صورة الانفصال عن التصور الهيغلي للشكل بما هو كلية روحية وبدقة أكبر بما هو كلية تعبيرية"[20].
يُقدّم سبينوزا تصوراً نظرياً للتأويل يقوم على أنّ الخطوات الإجرائية ينبغي أنْ لا تكون ملتبسة، فيكون المعنى خاضعاً لنوازع شتى تنتهي إلى إخراج النصوص الدينية من سياقاتها ووظائفها الأصلية إلى سياقات أخرى وظيفية تدمجها بخطابات إيديولوجية غايتها فَرْض السيطرة والاستحواذ. فمعظم المؤولين، كما يرى، ينطلقون من مبدأ كون النصّ المقدس - وذلك لكي يفهم بوضوح ويكتشف معناه الحقيقي- هو أينما كان صحيحاً وإلهياً بينما ينبغي أنْ يكون ذلك استنتاجاً لفحص متشدد لا يترك فيه أيّ غموض. وهذه هي الطريقة الآبائية القديمة في تأويل الكتاب المقدس، فقد انصبَّ اهتمامهم في المقام الأول على البحث الفيلولوجي عن "حقيقة النصوص"[21]. لكنّ سبينوزا جعل العدول عن البحث الفيلولوجي أساس نظريته التأويلية، ليبحث في داخل النص عن قيمته وعن غزارة المعاني التي يفصح عنها. وترتبط هذه النظرة بأساس إبستيمولوجي يبحث عن الحقيقة وعن المعنى في تجسدهما الموضوعي وبحث عن فاعلية العقل غير المرتبط بالمقدمات والموجهات والأحكام القَبْلية والطرائق المخادعة للتأويل الاستحواذي، وإنما العقل المستنير الذي يحفّز قدرة العقل على البحث عن الحقيقة، ويحفّز ملكاته القادرة على تكوين مقاربة نظرية وتاريخية تتيح له تفكيك شفرات النص.
ولم يكن بوسعه تحقيق ذلك الإنجاز الإبستيمولوجي لولا طريقته، كما يرى تودوروف، في فَصْل الإيمان عن العقل، وبالتالي فَصْل الحقيقة، ولو كانت دينية، عن الدلالات التي تتضمنها النصوص المقدسة في هذه الحالة. فالإيمان كما يرى مرهون بالعمل لا بالنظر، إنه يتطلب عملاً صادقاً أكثر مما يتطلب عقائد صحيحة.
وهذا التمييز، في حقيقته، هو تمييز بين رؤيتين معرفيتين مختلفتين؛ إحداهما رؤية عقلية والأخرى رؤية غائية وإيديولوجية، فهو قد حدّدَ منذ البداية أنّ الناس يدافعون بالعقل وحده عن كلّ ما يدركونه بالذهن الخالص، ويدافعون بانفعالاتهم عن المعتقدات اللاعقلية التي تفرضها عليهم انفعالات النفس وتجاوبها مع النسق الإيديولوجي وبلاغته الخطابية. وهذا ما جعله يتنبّه إلى قضية يمكن من خلالها التخلص من الأحكام اللاهوتية المسبقة، وهي أنْ نتحرر من المنهج الانفعالي إلى المنهج العقلي، فهو يعتقد لكي نخرج أنفسنا من هذه المتاهات ونحرر فكرنا من أحكام اللاهوتيين المسبقة وحتى لا نؤمن في غفلة منا ببدع من وضع البشر وكأنها تعاليم إلهية يجب أنْ نتحدث عن المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه لتفسير الكتاب، وهو مماثل للمنهج الذي نتبعه في تفسير الطبيعة ولا يختلف عنه في شيء، بل يتفق معه على جميع جوانبه، فكما أنّ منهج تفسير الطبيعة يقوم أساساً وقبل كلّ شيء على ملاحظة الطبيعة وجمع المعطيات اليقينية، ثم الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الطبيعية؛ فكذلك يتحتم علينا في تفسير الكتاب أنْ نحصل على معرفة تاريخية مضبوطة، وأنْ لا نبددها في هرطقات مشوهة، وموجهة لغايات لا تمت بصلة للنصّ.
وميزة منهجه في التأويل أنَّ له مبادئ مستنبطة من (العقل) ومن (النص)؛ فهو لا يهمل أو يتجاهل العناصر المتعلقة بالنص، التي ستكون مادة أولية للفحص والتحليل العقلي الذي يكتشف العلاقات بينها ليقرر حقيقة معينة. لذلك، تحدث على نحو واضح عن القصص والمعجزات والخرافات والرواة وموضوعات الوحي وعن القدسية وعن الفحص التاريخي وأسسه، وعن أهمية الجانب اللغوي وعن المعنى وكيفية تلقيه؛ فقد قال في مجمل تفسيره لأحد أقوال النبي موسى: على الرغم من كون المعنى الحرفي مناقضاً للنور الفطري، فإنه إذا لم يكن يتعارض على نحو قاطع مع المبادئ والمعطيات الأساسية التي نستمدها من التاريخ النقدي للكتاب؛ فمن الواجب الاحتفاظ به (أي المعنى الحرفي). وعلى العكس من ذلك إذا كانت هذه الكلمات تتناقض في تفسيرها الحرفي مع التي نستمدها من الكتاب، رغم اتفاقها التام مع العقل، فيجب قبول تفسير آخر لها (أعني: تفسيراً مجازياً). وفي هذا الموضع، يقترب من التأويل البنيوي للنص، وقد التقطَ ذلك تودوروف: إنَّ نقد سبينوزا هو نقد على مستوى البنية لا المضمون، فليست المسألة إحلال حقيقة مكان أخرى، وإنما تغيير مكان الحقيقة في العمل التأويلي[22].
[1]- مباحث المعتزلة الكلامية وموضوعاتهم حول الجدل الفلسفي وموقفهم النقدي من الفقهاء والمحدثين
[2]- رسالة في اللاهوت والسياسة – سبينوزا – ترجمة وتقديم: د. حسن حنفي، دار الطليعة، ط4، القاهرة، 1997- ص366
[3]- سبينوزا، ترجمة عقيل حسين – سلسلة أعلام الفكر العالمي – المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د.ت، ص20
[4]- ينظر: المرجع نفسه، ص20، ص30
[5]- المرجع نفسه، ص 144
[6]- رسالة في اللاهوت والسياسة، ص241
[7]- علم الاخلاق، سبينوزا، ترجمة: جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، تونس، د.ت، ص343
[8]- المرجع نفسه، ص337
[9]- المصدر نفسه، ص241
[10]- رسالة في اللاهوت والسياسة، ص242
[11]- علم الأخلاق، سبينوزا، ص351
[12]- رسالة في اللاهوت والسياسة، ص242
[13]- تنظر المدلولات العقلية في كتاب: دلالة الحائرين، موسى بن ميمون، ترجمة وتحقيق: الدكتور حسين آتاي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص67
[14]- المصدر نفسه، تعليق الدكتور حسن حنفي، ص242
[15]- المصدر نفسه، ص242
[16]- المصدر نفسه، ص242
[17]- ينظر: ماوراء المنهج، تحيزات النقد الأدبي الغربي – سعد عبد الرحمن البازعي- المجلة العربية للعلوم الإنسانية – ع38- مج10/1990 – ص71
[18]- ينظر: مصائر الفلسفة، جورج طرابيشي، دار الساقي، ط1، بيروت، 1998، ص25، 26
[19]- المصدر نفسه، ص26
[20]- قراءة رأس المال، لويس ألتوسير، ترجمة: تيسير شيخ الأرض، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 1972، ج1، ص13
[21]- ينظر: نقد النقد، تودوروف، ترجمة سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة، ط2، بغداد، 1986، ص21
[22]- ينظر: المرجع السابق نفسه، ص20