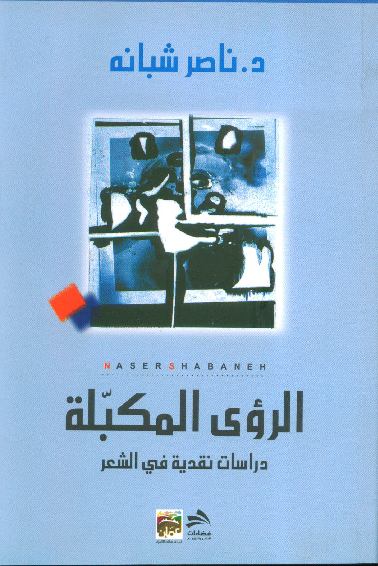الرّؤى المكبّلة: دراساتٌ نقديّة في الشّعرِ للدكتور ناصر شبانة

في البدايةِ، لا أجاملُ بالتّعبيرِ عن امتناني لأساتذتي بالجامعةِ الهاشميِّة، كما لا أترددُ بتجديدِ شكري مرّة ثانية لأستاذي الدّكتور ناصر شبانة، وقد أهداني كتابهُ الذي نحن بصددِ الحديثِ عنهُ الآن منذُ ما يزيد عن سبعِ سنوات.
على كلّ، فإنّ الكتابَ يقعُ في مئتين وست وستين صفحةً من الحجمِ المتوسّط، ويتوزّعُ على مقدّمةٍ وثلاثةِ فصولٍ، وقد صدرتْ الطّبعة الأولى سنة تسعٍ وألفين عن دارِ فضاءات في عمّانَ، وفي هذا الصّددِ، لا بدّ من الإشارةِ إلى أنّ فصولَ الكتابِ كانَت في الأصلِ أبحاثًا ودراساتٍ، شغلَ المؤلّفُ نفسَهُ بها على سنواتٍ خلت. وعلى ذلك، يُعدّ الشّعرُ الحديثُ خيطًا يجمعُ الدّراساتِ، ولا يتحرّج المؤلّفُ في مقدّمةِ كتابهِ القولَ بأنّ لغةَ الكتابِ مما يغري الإدهاش والاحتجاج؛ كونها بعيدةً عن الوضوحِ والمباشرةِ. من هنا، نطمحُ إلى تقديمِ ملّخصٍ وعرضٍ؛ بهدفِ استكناه مضامين الكتابِ واستجلاء مراميه محاولاً ما أمكن الاختصار والإيجاز.
في الفصلِ الأوّل، يتحدّثُ شبانة عن علاقةِ القارئِ بالنّصِّ، ويرى بأنّ ثنائيّةَ السّلطةِ والتّحررِ ظلّتْ تحكمُ علاقةَ القارئِ بالنّصِّ، كما يرى بأنّ ثمّة توافقًا وتواطؤًا بين الشّاعرِ والقارئِ أقرّتها أعرافُ الكتابةِ الشّعريّةِ، وأنا أجاريه في قوله بأنّ الشّاعرَ كان مسيطرًا على فضاءِ النّصِّ الشّعريّ، وظلّ القارئ حريصًا على تقديمِ الولاءِ والطّاعةِ لقربانِ القصيدةِ المقدّس. كما أتفقُ مع وجهةِ نظره القائلة بأنّ الشّاعرَ ظلّ حريصًا على إقصاءِ القارئ عن ممارسةِ دوره الطّبيعيّ في التّعاملِ مع النّصِّ، مكتفيًا بمنحهِ حصّة محدودة من النّصِّ، ملزمًا القارئ باتّباعِ نهجه، وخطّ سيره، وبقولِ ما يريد قوله.
إنّ تحررَ القارئ راجعٌ في نظرِ المؤلّفِ إلى الكبتِ، من هنا، بات القارئ يشارك الشّاعرَ عمليّة إنتاجِ النّصِّ ودلالته مع إعطائه صلاحيّة التّصرّف بالنّصِّ، وتمتّعَ بهامشٍ واسعٍ من الحرّيّةِ. وعلى هذا، يتساءلُ المؤلّف فيما إذا كان القارئ سعيدًا بهذه الصّلاحيّة الواسعة، أم أنّه باتَ يعاني من الإرباكِ نتيجة انسحابِ الشّاعرِ من نصّهِ. وهذا سؤالٌ في نظري يستحقُّ الوقوف طويلاً أمامه. لهذا، يرى شبانة بأنّ القارئَ مطالبٌ بامتلاكِ أدواتٍ جديدةٍ؛ تمكّنه من السّيطرةِ على النّصِّ، ويتسلّح بثقافةٍ معرفيّةٍ عميقة توازي ما لدى الشّاعر أو تزيد، مما يجنّبه الوقوع في شَرْكِ فوضى النّقد. إنّ المؤلّف لا يظلّ على رأيه هنا، بل ذهب أبعد من ذلك، في أنّ الخطورة تكمن في ما سمّاه بإساءةِ استخدامِ القارئ السّلطة، وغياب الرّقابة، مما قد يدفعه إلى تقويل النّصّ ما لم يقله، أو التّهويم في دوائرٍ من فراغ.
يتطرّق شبانة إلى مقولةِ موتِ المؤلّفِ الشّائعة في النقدِ الحديثِ، ويعزز قوله برولان بارت بأنّ ملكيّة الشّاعر انتهتْ. ويرى بأنّ القارئَ تحوّلَ من مستهلكٍ للمادّةِ النّصيّةِ إلى منتجٍ، هذا ويشبّه الشّاعر بالجبروت، وقد سيطر وَهْمُ القوةِ وجنونِ العظمةِ عليه بأنّه باقٍ ما بقيتْ قصيدته. كما يرى بأنّ القارئَ أدّى دورَ المعيلِ والكفيلِ والوريثِ على نصوصِ الشّاعرِ وإبداعه، ولم يعدِ الشّاعرُ معنيًا بعمليّةِ حصرِ الإبداع. وبهذا، على القارئِ أن يتعاملَ مباشرةً مع النّصِّ، دون وسيطٍ أو دليل، وأنّ الذي يعجب به مؤلّف الكتابِ، على الرّغمِ من أنّ هامشَ الحرّيةِ اللامحدودة الذي منحه النّصّ الحديث للقارئ، إلّا أنّه ما زالَ غير قادرٍ على التّعاملِ معهُ، وكأنّهُ استعذبَ القمعَ والعبوديّة حسب تعبيره.
يوسّعُ المؤلّف ملاحظته النّقديّة السّابقة في مبحثٍ معنونٍ بتحوّلاتِ القراءةِ في الشّعرِ الأردنيّ، ويتطرّقُ إلى نظريةِ التّلقي، ويرى بأنّهُ يقتضي التّحررُ من سلطةِ النّصِّ، والاعترافُ بموتِ الشّاعرِ بمجردِ الانتهاءِ من أداءِ مهمّته الشّعريّة في عصرِ الانفتاحِ والحرّيات.
ويستنتجُ أنّ الشّاعرَ لا يكتب عادةً إلّا وهو يضمرُ في ذاكرته قارئًا متخيلًا يوجّهُ لهُ خطاب النّصِّ، ويخلصُ إلى أنّ علاقةَ الشّعرِ الأردنيّ بالقارئ، لا تختلف عن علاقةِ الشّاعرِ العربيّ بقارئه، وعلى هذا الأساس، فإنّ القارئَ في علاقتهِ بالقصيدةِ -كما يرى- مرّ في أطوارِ القراءةِ الثلاثةِ التّالية: القارئ المدلل، والقارئ النّشط، والقارئ المضلّل. في القارئِ المدلل ربطَ شبانة بداياتِ الشّعرِ الأردنيّ ببلاطِ الأميرِ عبدالله، وقد كانَ القارئُ مجرّدَ مستقبلٍ، وبهذا، فإنّ علاقةَ الشّاعرِ بقارئهِ خلال هذه المرحلة اتّسمتْ بالصّفاء، ولم تتعدَّ على أحسنِ تقديرٍ علاقة الصّوتِ بالأذنِ، بدليلِ أنّ قصائدَ هذه المرحلة كتبت تحت وطأة المناسبة، ولعلّ أكبر دليل على ذلك قصائد عبد المنعم الرّفاعي. أمّا علاقة الشّاعر بالقارئ النّشط فقد اتّسمت بالتّقدير، والاحتفاء، والاحترام لقدرته؛ ذلك من خلالِ منح الشّاعرِ القارئ دورًا أكبر في الدّخولِ إلى نصِّهِ ومحاورته، وتأويله، وإعادة إنتاجه؛ ساعيًا لخلقِ قارئٍ مثالي، يمتلكُ القدرةَ على تأويلِ النّصِّ وتنشيطه، ويجدُ شبانة عرارًا مثالاً بارزًا على ذلك. وقد شكّلتْ مرحلةُ علاقةِ القارئِ المضلّل بشاعرهِ شكلاً من الانفصامِ، والقطيعة، والفتور، والضّياع، والضّلال، والسّبب في ذلك إنّما يرجع في اعتقادِ المؤلّفِ بفسادِ ذوقِ القارئ، وعجز الشّاعرِ عن خلقِ قارئٍ يمتلكُ قدراتٍ في فكِّ طلاسمِ النّص.
تناول المؤلّفُ في الفصلِ الثانيّ تجارب شعريّة لثلاثةِ نماذج من شعراءَ متعددي الاتّجاهاتِ والنّزعاتِ على التّوالي: محمود درويش، وعبد المنعم الرّفاعيّ، وزياد العناني. وينطلق في مبحثِ مفاتيح البنية في ديوانِ "لماذا تركتَ الحصان وحيدًا"، من فرضيّةٍ مفادها أنّ محمود درويش واحدٌ من الذين ملأوا شقوق اللحظةِ الزّمنيّة الجائرة بفيوضٍ شعريّة، وانطلاقًا من هذه الفرضيّة، يتوسّل المؤلّف في دراسته بأدواتِ المنهجِ البنيويّ في الكشفِ عن أسرارِ البنية وكشف حركتها.
يقاربُ المؤلّفُ في مفتتحِ دراسته عنوان الدّيوان بوصفه إشارةً من إشاراتِ الغلافِ، ويكتشفُ أنّ العنوانَ مجتزأ من سياقٍ حواري وردَ في قصيدةِ "أبد الصّبار"، ويذهبُ إلى أنّ الحصانَ يمثّل عزّة الإنسان وقوّته، وخلص إلى التّأويلِ بأنّ اختيارَ درويش السّؤال لدعوةِ القارئ إلى المشاركةِ الفاعلةِ في البحثِ عن الإجابة؛ إذ إنّ السّؤال لماذا ـ كما يرى ـ من أعقدِ الأسئلةِ وأعمقها، ويرسم علاقة وجوديّة بين السّببِ والمسبب. وعلى العمومِ، فإنّ سؤالَ درويش من أجلِ إثباتِ العجزِ عن الإجابةِ.
إجرائيًّا، قسّم البنية النّصيّة إلى أربعةِ مفاتيح: البنية التّكراريّة، واللزوميات، والتّناص، والبنية الإيقاعيّة. في البنيةِ التّكراريّة، يرى أنّ درويش جعلَ من التّكرارِ مرتكزًا ترتكز عليه جدارات الرّؤية، وذلك في إطارِ ما سمّاه بإعادةِ إنتاجِ الدّلالةِ؛ إذ إنّ السّمةَ التّكرارية تظهر بوضوحٍ في البنى بمجموعةٍ من الحروفِ والحركاتِ في قوافي الأبياتِ في قصيدةٍ واحدة. بناءً على التّحليلِ البنيويّ، يظهر التّناصُ في شعرِ درويش بأشكالٍ مختلفة؛ الأسطوري، الرّمزيّ، الذّاتيّ، الدّينيّ، الشّعبيّ.
واستقرائيًّا، يستنتج شبانة أنّ درويش يوظّف في ديوانهِ البحور العروضيّة، كما أنّ الظاهرةَ الإيقاعيّة تتمثّل في التّدويرِ ومحاولة كسر ِالمألوف في قصيدةِ التّفعيلة. ومن خلالِ إعادةِ توزيعِ التّفعيلات، اكتشفَ أنّ بعضَ المقاطع جاءتْ على هيئةِ القصيدةِ التّقليديّةِ، بحيث تندرج القصيدةُ ضمن ما اصطلح على تسميتها بالشّكلِ الهجين.
وفي الفصلِ الثاني، يجدُ القارئ المبحث الذي حمل الكتاب عنوانه بالرّؤى المكبّلة، وقد سُلط الضّوء على ديوانِ المسافرِ لعبدِ المنعم الرّفاعي، الذي يعكسُ مثل هذا الفهم وتمّ تناولها بالتّحليلِ. ويعدّ الرّفاعي من الشّعراءِ المقلدين، ومن مظاهرِ التقليد عند الرّفاعي كما يراها المؤلّفُ، تتمثل بالتّمسكِ الأمينِ بحيثياتِ القصيدةِ التّقليديّة، ومما يجدر ملاحظته أنّ الرّفاعي شاعرُ مناسبةٍ بامتياز. والمناسبة هي التي تفرضُ على الشّاعرِ مفرداتها، وصورها، وعروضها، وشكلها. وعلى ضوءِ ذلك، يفرد شبانة التّكرار والتقسيم كتقنية فنيّة، وبالنّتيجة، فإنّ التّكرارَ في شعرِ الرّفاعي جسّد ضربًا من التّرنم. ويرى بأنّ المعجم الشّعريّ عند الرّفاعي يتوزّع على حقلين دلالين: أولهما يعبّر عن لغةٍ تقليديّة، وثانيهما ينتمي إلى مفردات الطبيعة، وهذا ما جعله يرجّح تأثّر الرّفاعي الواضح بالمذهبِ الرّومانسي. كما تُشكّل الصّورة الفنيّة ثيمة أساسيّة من ثيماتِ البناءِ في شعرِ الرّفاعي، ونهاية المطاف في مبحثِ شعرِ الرّفاعي، وجد أنّ قفلةِ القصيدةِ عند الرّفاعي تقوم بأدواتٍ متعددة، منها النّهاية المفتوحة، والمغلقة، والمعلّقة.
وأخيرًا، قدّم المؤلّف دراسةً عن مجموعة خزانة الأسف الشّعريّة للشّاعرِ الأردنيّ زياد العناني، من خلالِ مقاربتها رؤيةً وشكلاً وفقَ ثنائيّة المقدّس والمدنّس، وأحسبُ أنّ هذه الدّراسة رائدة في مجالِ الدّراسات الأردنيّة النّزيرة من حيثُ علاقتها بالتّابو. قد نوافق المؤلّف في قوله بأنّ اللاوعي يؤدّي دورًا مباشرًا في خلقِ الرّؤيةِ الفنيّة، إلّا أننا لا يمكن القول على سبيلِ القطعِ والجزم؛ لأنّه يتعارض تمامًا مع ما اصطلح على تسميته ـ سابًقا ـ بقصيدةِ المناسبة. عمومًا، لا يجد شبانة مناصًا في دراسته من الاستعانة بالمنهجِ النّفسيّ، مما كان مدعاة له لممارسةِ دور الطّبيب النّفسيّ؛ في سبيلِ تجميعِ شتات اللاوعي ورسم خريطة البنية النّفسيّة لذات شاعرة متشظية وتائهة، تعاني في نظره من حالةٍ أشبه ما تكون بالعصاب والفصام جرّاء حالات الحرمان، والتّهميش، والكبت، والخوف، لتقترب الذّات الرّازحة تحت وطأة اللاوعي من حافةِ الهذيانِ والجنون، مما من شأنها خرق المعيار، وهتك حرمة المقدّس، وما هو مألوف واعتيادي، والتّمرد على المحظور بما فيه الأعراف والقيم الدّينيّة والاجتماعيّة، ومواضعاتها في أنساقٍ شعريّة مفرطة بالجراءةِ، مما يحمل الرّؤية على أن تنفتح على فضاءٍ رحبٍ من الحرّيةِ، واعتمادًا على البناءِ المفارقِ في تزيينِ القبيحِ وتقبيح الحسن، يدخل المقدّس بالمدّنس في نصوصِ العناني الشّعريّة، وهذا بالضّبط ما يتضح في كثير من مواقع الدّراسة، وهو نفسه ما عبّر عنه مؤلّف الكتاب من خلالِ سبرِ أغوارِ النّصوصِ وتحليلها. من هنا، يحاور البنى اللغويّة في المجموعةِ رغبةً في فهمِ الرّؤيةِ الشّعريّةِ الممعنة في تمزّقها، واضطرابها، وقتامتها، وبؤسها، إلى جانبِ استظهار حالة الذّات، من خلالِ سبر أغوارها وفهم مكنوناتها الدّفينة في نصوص العناني.
يتوزّع الفصلُ الثالثُ على مبحثينِ، في المبحثِ الأوّلِ، حرصَ المؤلّف على رصدِ واقعِ الشّعرِ الجديدِ في البلادِ العربيّة، من خلالِ السّماتِ والملامح، وقد اتّخذ نصوصًا شعريًا مدارًا للتحليل والنّقاش. ويذهب إلى أنّ مصطلحَ الشّعرِ الجديدِ يشير إلى النّتاجِ الذي ظهر في العقدِ الأخير من القرنِ العشرينِ واستمرّ حتّى هذه اللحظة. وعلى ذلك، يعاين ملامح الرّؤيةِ في قصائدِ هذا الجيل، من خلالِ ثلاثيّةِ متداخلة الأطراف، هي: الانكسار، والرّفض، وخلق البديل. وبالمحصّلةِ، خلص إلى أنّ فضاءَ الرّؤيةِ في نصوصِ الشّعرِ الجديد موغل بالانكسار، والتّشظي، والتّمزق، والاغتراب، والشّعور المفجع بالاستلاب، في زمنِ العولمةِ، والفضائيات، وشبكة الإنترنت، وهذا تمامًا ما انعكس على البنية اللغويّة والنّفسيّة.
وأيًا مما كان الأمر، فإنّ الشّعرَ الجديد يمنح القارئ سلطات واسعة في قراءة النّصّ، وعلى هذا الأساس، يذكر المؤلّف أنّ تداخل الأنواع الأدبيّة كالقصّة، والمسرحيّة، والسّيرة، ملمح من ملامح النّصّ الشّعريّ الجديد.
أمّا المبحث الثاني من الفصلِ الثّالثِ، فيستثمر المؤلّف التّناص بوصفه تقنية واسترتيجيّة فنيّة جماليّة ومعرفيّة في النّصّ الشّعري العمانيّ، ونظريًّا يقدّم مفهومًا للتّناص على ضوءِ ما جاء عند الدّارسين والباحثين، بحيث يمكن تعريف التناص تعريفًا بسيطًا ومتداولاً، بأنّه لوحة فسيفسائية من الاقتباسات والتّضمينات، وهذا نفسه ما انتهت إليه جوليا كريستيفا. وبهذا المنطلق، يتتبع تجلّيات التّناص القرآنيّ في الشّعرِ العمانيّ الحديث وطريقة توظيفه وتطويعه. وبالنّتيجةِ، راوح التّناص في الشّعرِ العمانيّ بين الشّكلين: التّصريح والتّلميح.
والمحصّلة النّهائيّة؛ فإنّ الخلاصةَ العامّة التي يمكنني الخروج بها، أنّ الكتاب محاولة كسر للرّؤيةِ النّمطية السّائدة عن الشّعرِ والنّقد، وخلق قارئ فاعل وناشط؛ ذلك من خلالِ الدّعوةِ إلى التّفكيرِ النّاقد العميق، والتّمردِ على مقاييسِ النّقدِ القديمة، والتّحرر من قيود التّبعيّة، ومواجهة النّصوص الإبداعيّة بطريقة أكثر حداثة وانفتاحًا، دون الاستسلام والخضوع للدّلالات الجاهزة والسّاذجة.
ويظلّ السّؤال قائمًا ما إذا كان على القارئ الدّخول إلى النّصّ الشّعريّ الحديث بأدواتٍ قديمة؟
باحث وناقد مستقل ـ الأردن.