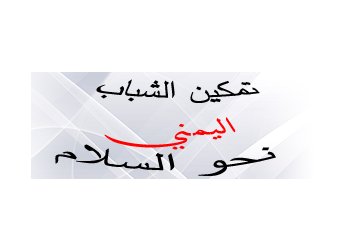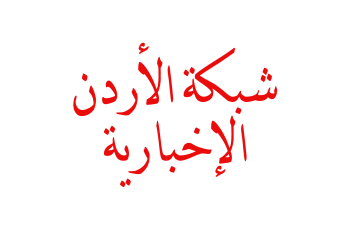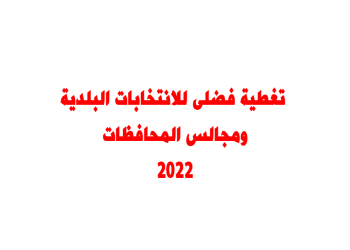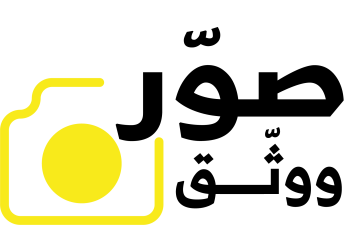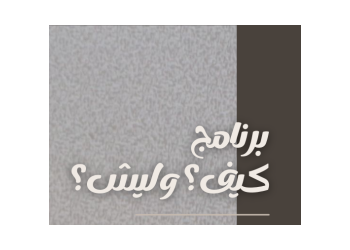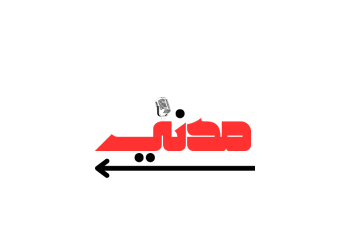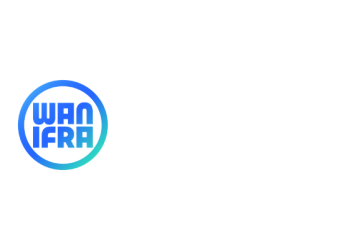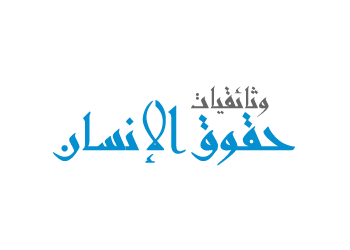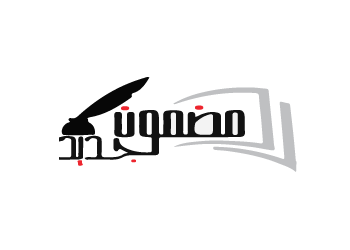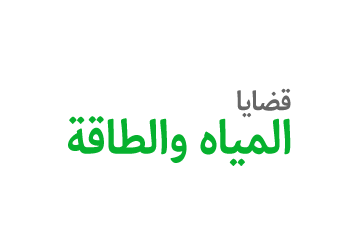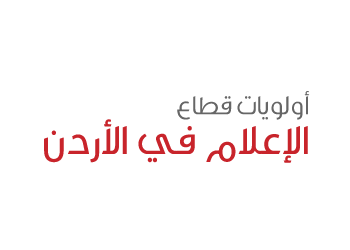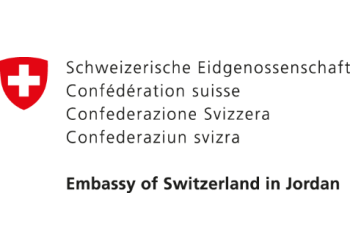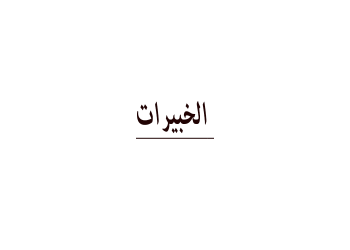سمك لبن تمر هندي

الإعاقة من المفاهيم التي تجسّد غلبة النمط وسيطرته على مجتمعاتنا العربية، فما تكوّن لدى الكثيرين من صور نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً من الحلقات الدرامية والأفلام السينمائية والأمثال الشعبية، ناهيك عن الكتب المدرسية قديمها وحديثها؛ بات من المُسَلَّمات التي تقهر كل مغاير ولو كان عين اليقين.
الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية طليقوا اللحى متسخي الثياب يصرخون “حيّييييييي، الّله، هو اللي شايف ومحدش غيره عارف، حيّيييييييييي”، ثم يتضح في نهاية الحلقة الأخيرة من المسلسل أنّ مفتاح الحقيقة عند هذا “المبروك”، الذي يعرف القاتل والقتيل والشهود ومكان الجثّة.
الشخص ذو الإعاقة الجسدية سواءً على كرسي متحرك أو على عكاز، يجب أن يكون هادئ الطبع خافت الصوت حساس لكل كلمة، يقاوم حبه لفتاته لأنه يعتقد أن شعورها نحوه “شفقةً” وليس حبّاً على الرغم من الأيمان والأحضان التي ما تَنفَك تغمره بها.
شخصية الكفيف أفضل حظّاً من سابقَتَيها في الذهن الجمعي لمجتمعنا عاشق الدراما، فالكفيف النمطي غالباً ما "يَنتَع" أمامه كرشاً ممتداً 3 أو 4 أشبار من نقطة انطلاقه تحت قفصه الصدري، وهو أيضاً ذو أنف “كلابية” تَشتَم رائحة الطعام والنساء عن بعد، وهو حاد السمع كالخفافيش، فما أن يطرق طبلة أذنيه طقطقة كعب حذاء “حريمي” سواءً كان “باتا” أو “غوتشي”؛ حتى يبدأ بالزمجرة والتمتمة “همممم..... الله! الله! الله! غزال وماشي! أكيد حلوة! لا وكمان لَدِنَة! براهن إنها لَدِنَة!”.
ولتكتمل الصورة في أوج نمطيتها، فلا بد أن يجلس صاحبنا وقد عانقت بطنه الممتلئة بطن عوده الرنان الذي تستغيث أوتاره من ضرب ريشته الثقيل عليها، ثم يشرع في غناء “طقطوقة” أو دور لـ زكريا أحمد أو سيد درويش وغالباً ما تكون كلماتها خليعة وألحانها راقصة وتصف حالة من بحث عاشقَين عن النشوة تتمنّع فيها المرأة وهي راغبة ويتوسل إليها الرجل بكلمات غزل صريح، هذا كلّه طبعاً يغنّيه الشيخ الطروب اللعوب من خلف نظّارته السوداء بصوت خشن وعر مثل طريق عمان العقبة الصحراوي الذي أقسمنا أن نظلّ أوفياء لحفَره وجوَره ومطباته.
سؤال “هل تحفظ القرآن”، هو من الأسئلة الإجبارية في امتحان القدرات الذي يجريه لنا كل من يتطوّع مشكوراً لمساعدتنا خصوصاً من سابلة وسط البلد. المشكلة أن إجابتنا يجب أن تكون نمطية هي الأخرى، فإذا قلت بأنك لا تحفظه كاملاً، ازدراك السائل وأخذ يقارنك بالشيخ الكفيف عبد الحافظ؛ الحافظ للقرآن الكريم منذ أن كان في السابعة من عمره.
طلب الدعاء من الطلبات اليومية التي يقدمها المتعبون في هذه الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً المكفوفين منهم، بغض النظر عن ديانتهم أو طبيعة علاقتهم بربهم. فمن انتهى للتو من ارتكاب “خطيئة” في حانة أو سيارة، يرى في مصادفة شخص كفيف في الطريق؛ إشارة من السماء، إذ يهرع إليه طالباً منه الدعاء والشفاعة، “ادعيلِ يا شخي الله يغفرلي، والله يا شيخ أنا طيب وكويس، فكرك ربنا بسامحني علّي عملته؟”، “عدم المآخذة شو عملت؟”، “يا شيخ! إنّ الله حليمٌ ستّار”!
فرضية أن الكفيف مسلم ابتداءً ورجل دين مستجاب الدعاء انتهاءً؛ تبدو حتمية وغير قابلة للنقاش. لا زلت أجد صعوبةً في تصديق ما رواه لي أكثر من أربعة من الأصدقاء الذين كانوا يتجوّلون في شارع بارطو في الأشرفية، وكان بينهم قسيس كفيف يلبس صليباً كبيراً على صدره، فجاء أحد المارة وأمسك بيده وقال له: “على وين يا مولانا؟ بالله عليك ادعيلنا يا شيخ؟”!
لا يقتصر النمط بطبيعة الحال على الإعاقة وربطها بالروحانيات و"الميتافيزيقا"، إذ يجد النمط أيضاً أفقاً واسعاً في كل مرّة ينجح أحدهم في المزاوجة بين الحاجة الجسدية أو النفسية الملحّة للآخر من جهة، وبين الروحانيات والخرافة من جهة أخرى.
لم أكن قد بلغت العاشرة حينما اصطحبتني جدّاتي الثلاث (أم أبي وأم والدتي وأم جدتي لأمي) إلى إحدى “المبروكات” التي ذاع سيطها في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وبعد رحلة وعرة من حي الأرمن في جبل الأشرفية إلى مخيم البقعة حيث تسكن الشيخة “مدللة”. سرتُ مع الجدات في أزقة وطرقات طينية غير معبدة، حتى وصلنا إلى باب خشبي قديم مفتوح يؤدي إلى “حوش” أرضيته من “الباطون” بها تشقّقات طولية وعرضية ومتعرّجة بالكاد كنت قادراً على رؤيتها، حيث كان نظري يخفت عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر. راعني صوت سحجات قوية تنبعث من إحدة الغرف المطلّة على “الحوش”، فسألت جدتي أم أبي بصوت منخفض: “بضربوا مين جوه؟”، ضحكت وقالت: “بعالجو واحد مريض”. لم يستمر خيالي طويلاً في رسم صورة ما يحدث في الداخل، حيث جاء دورنا من بين العشرات الجالسين في انتظار المثول بين يدي “المبروكة”. كانت غرفةً تحيط “جنبيات الإسفنج” بها وفي وسطاها جزيرة إسمنتية غطى منتصفها حصيرة مهترئة، أجلسوني فوق الحصيرة بينما تحلّقت الجدات من حولي. نظرت إلى “المبروكة” فإذا بها تحمل سجادة صلاة حمراء اللون وقد طوتها على ثنيتين، ثم كشفت كبريات جداتي عن ساقيها المترهلتين لتهوي صاحبتنا عليهما بالسجادة وكأنها “تنجّد فرشة قطن” استعداداً لليلة الزفاف، ثم أخذت زجاجة صغيرة وسكبت منها زيتاً لتدهن به ساقي جدتي ثم والتها بالضرب على ساقيها، وجدتي تقول: “الله.... الله.... يا سلام.... جزاكي الله خيراً يا شيخة”. دارت الشيخة على جَدَّتَي الأخريتين بالطقوس ذاتها.
غطّت العجائز أرجلهن وقبل أن ينهضن، نظرت أم جدتي إلى الشيخة وقالت لها بنبرة متوسلة: “يا شيخة؟ شوفي هالولد، بلكي عالجتي عينيه مسكين عشان أهله”، فوراً ودون فاصل قالت الشيخة: “هاظ ملوش علاج يا حجة”. بنبرة أكثر توسّلاً واسترحاماً رجتها الجدّة: “أيّ يالّله عاد، تِفّيلِك تَفّة في عينيه وناوليه كم خبطة على رأسه يمكن الله يوخذ بالإيد”. كانت هذه واحدة من اللحظات القليلة التي آثرت فيها كفّ البصر على الإبصار.
تركنا بيت الشيخة وعدنا إلى منزلنا، وتوفيت جَدَتَي بعدها بخمسة عشر عاماً ولم تبرحهما آلام أرجلهما، بينما عانت جدتي أم والدتي أطال الله في عمرها لسنوات من الألم إلى أن عالجها طبيب سوري بالأدوية ومن دون بصق وخبط ونفض وتفعيص.
الخرافة تتلبّس من يؤمن بها، والنمط يستعبد أصحابه ليجدوا أنفسهم كأهل الكهف، فاتهم الزمان، فلا هم عاشوا زمانهم ولا تعايشوا مع زمان غيرهم، لتغدو حياتهم خليطاً غير متجانس “سمك لبن تمر هندي”.
مهند العزة: خبير دولي في التحليل القانوني وحقوق الإنسان، وكاتب في حقل الإصلاح الديني.