الدفاع المتعصب عن الهوية في الفن العربي ذريعة لرفض التطور

تطورت النظرة إلى الصورة ومفهوم البشر حول الفن عبر التاريخ، ونقصد بهذا المفهوم فكرة التعبير الحر، الذي يختلف عن الصنعة أو صناعة الصورة كحرفة. استمر هذا المفهوم في التطور وتكشفت ملامحه الجديدة بظهور المدارس الفنية المختلفة من تعبيرية وتكعيبية وسوريالية، وغيرها من المُسميات التي ظهرت ونُحتت في الغرب تحديداً. كانت البدايات الأولى لمعظم الحركات الفنية في العالم تمثل انعكاساً لتطور النظرة إلى الصورة، أو مفهوم الفن في صورته الغربية، حتى مُسمى "الفنون الجميلة" الذي أُطلق على مؤسسات تعليم الفن في مصر وغيرها من البلاد العربية مثلاً ما هو إلا ترجمة حرفية للمصطلح الغربي "FINE ART" الذي تطور في أوروبا بهدف التفريق بين فنون التعبير وغيرها من الوسائل الحرفية الأخرى التي تتسم بالصنعة.
وحين أنشئت المعاهد والكليات الفنية في المنطقة العربية في مطلع القرن العشرين، اعتمدت في الغالب على المنهج الغربي في تدريس الفن ومفهومه الشائع وقت إنشاء هذه المعاهد والمؤسسات. وعلى مدار القرن الماضي سعى الفنانون العرب للبحث عن سمات تُميزهم، اعتماداً على طبيعة المكان والموروث التاريخي والبصري والاجتماعي. ولا شك أن هناك فنانين كُثُراً قد نجحوا في تحقيق ذلك الأمر، وكانت لهم بصمات ومساهمات مميزة في هذا الإطار. غير أن هذه الإسهامات والإبداعات المتعددة لم تبتعد أبداً عن تقاليد الممارسة الفنية التي وُضعت أُسُسها في الغرب. ونقصد هنا تلك الممارسات التقليدية من تصوير ونحت وغيرها من الوسائط التي اصطُلح على إدراجها ضمن إطار الفنون الجميلة. وهو أمر لا يعيب هؤلاء الفنانين ولا ينتقص من تجاربهم، فالحضارات والثقافات على مدى التاريخ الطويل للبشرية تؤثر بعضاً في بعض وتتمازج وتتلاقح فيما بينها. فنانو الغرب أنفسهم تأثروا بالموروث البصري للشرق، وكان هناك دور واضح ومؤثر مثلاً للمنحوتات الأفريقية في تطور مفهوم الفن والأساليب الغربية في معالجة الأشكال رسماً ونحتاً.

لوحة للرسام العراقي ضياء العزاوي (موقع الرسام)
حين أنشئت مدرسة الفنون الجميلة في مصر في بداية القرن الماضي، كأول مؤسسة وطنية لتعليم الفن اعتمدت بالطبع على فنانين أجانب، حتى تهيأ من خريجيها المصريين من تسلم الراية. وقد ظلت عمادة الفنون الجميلة في مصر قاصرة على هؤلاء الفنانين الأجانب (فرنسيان وإيطالي) حتى تولاها مصري بعد حوالى ثلاثين عاماً من إنشائها، وتحديداً في عام 1937 حين تولى الفنان محمد ناجي منصبه كأول عميد مصري للفنون الجميلة. ظلت الدراسة في هذه المؤسسة الجديدة معتمدة على منهج غربي، ومايزال المنهج نفسه حتى اليوم دون تغيير، عماد الدراسة في معظم كليات الفنون في مصر، مع اختلاف نوعي تبعاً لتوجه المؤسسة التعليمية. خلال فترة الدراسة في هذه المعاهد والكليات يجب على الطلبة دراسة تاريخ الفن من منظور غربي، والتعرف على أساليبه ومدارسه المُتعددة. وقد وُضعت هذه المناهج التعليمية بهدف تلقين وتدريب الدارسين على أساليب أومباديء التعبير الفني المُختلفة، كمهارات لازمة للممارسة الفنية، بما يتسق مع طبيعة الفن ومفهومه الذي تطور في الغرب.
تطور المفهوم
وكما تطور مفهوم الفن ليصل إلى هذه المرحلة، فقد استمر في تطوره ولم يتوقف. منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم طرأت على هذا المفهوم العديد من المُتغيرات، فاختلفت النظرة الشائعة حول الممارسة الفنية والتعبير البصري عما كانت عليه في بداية القرن العشرين. لم يعد هذا التعبير قاصراً على اللوحة والتمثال وغيرها من أساليب الفن الحديث. ظهرت وسائط جديدة وامتزجت بأخرى كنتيجة طبيعية للتطور والاكتشاف والبحث وإمعان التفكير. تغيرت الرؤية إلى العمل الفني وتعددت أشكاله ووسائطه. إقتحمت المشهد البصري وسائط مختلفة كالفيديو والفوتوغرافيا والتحريك والصوت، بل أقحم الفنانون أنفسهم في صُلب العمل وصاروا جزءاً منه. انتهى عصر المدارس المؤثرة، وظهرت مفاهيم جديدة مثل ما بعد الحداثة والمعاصرة. المفهوم الأخير تحديداً مازال يتطور إلى اليوم وتتسع مساحة تعريفه. لكنه في المُجمل يُشير إلى اتساع رقعة التعبير الفني لتشمل كافة الممارسات الفنية البصرية من دون تهميش أو إزاحة لأحدها. لم يعد التعبير الجمالي هو الهدف الأسمى للفن، كما لم تعد اللوحة والتمثال هما السيد الجالس على عرش الممارسة الفنية، بل صارا جزءاً ضمن مجموعة واسعة من الممارسات الأخرى. حدث هذا ويستمر في الحدوث، في الوقت الذي ماتزال فيه المؤسسات التعليمية في مصر وفي كثير من البلاد العربية مُتمسكة بالمنهج والمفهوم نفسه للفن كما كان عليه في مطلع القرن العشرين.
هناك بالطبع من ضاقت صدورهم بهذا الاتساع في مفهوم الفن الذي فرضته المعاصرة، وظلوا ينظرون بعين الشك إلى هذه الأفكار والممارسات الجديدة، مع تشوش واضح في فهمهم للمُصطلح وارتباك في التعريف؛ إرتباك يخص حتى طبيعة الممارسة الفنية نفسها. لا يتعلق هذا الأمر بمصر أو منطقتنا العربية فقط، بل يطاول ثقافات أخرى أيضاً بدرجات متفاوتة. حتى في الغرب تعلو بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تتعامل بعدائية مع مثل هذه الأفكار والممارسات. نعم، حتى في الغرب نفسه هناك من يؤمنون بأن ثمة قوة شريرة تسعى لتشويه أفكار البشر وقناعاتهم المستقرة والراسخة حول الفن. المثير للانتباه هنا أنه على الرغم من تهافت هذه الأصوات وضعف منطقها يعن للبعض عندنا إستدعائها أحياناً، كدليل قاطع يؤكد وجهة نظرهم الرافضة لهذه الممارسات، وهو ما يعكس قبولهم بأن القول الفصل في أمور الفن يأتي دائماً من هناك.
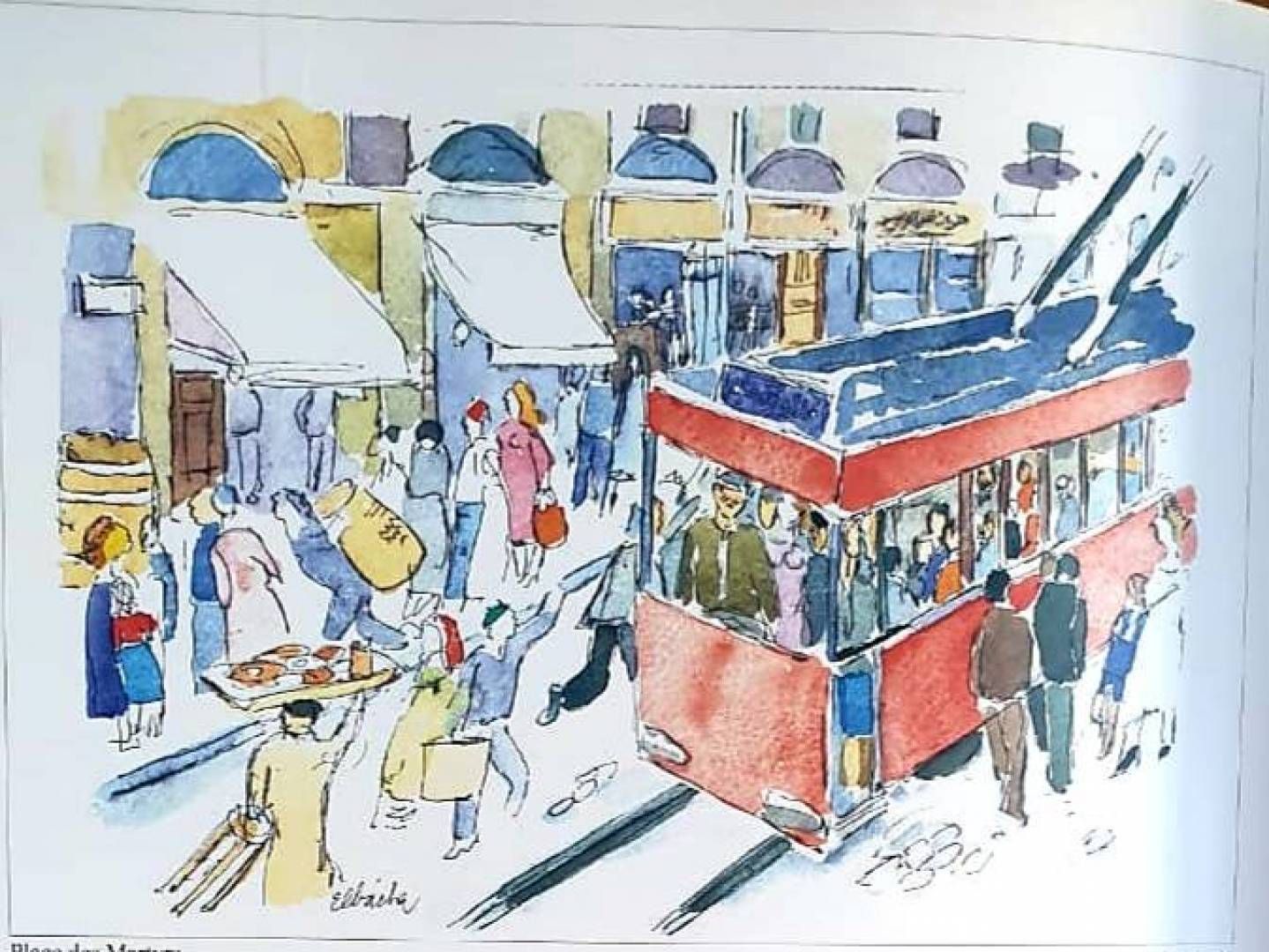
لوحة للرسام اللبناني امين الباشا (موقع الرسام)
الغريب في الأمر أن هؤلاء غالباً ما يتعاملون مع الممارسات الحداثية كإرث وطني يجب عدم المساس به أو الخروج عن إطاره، مُستخدمين شعارات كالأصالة والهوية. علينا هنا أن نتوقف قليلاً، ويحق لنا أيضاً أن نتساءل حول علاقة هذه الممارسات بفكرة الهوية، وكيف تُهددها أو تنال منها؟ هل رأى هؤلاء مثلاً أن هذه الممارسات الفنية عاجزة عن التفاعل مع عناصر ومفردات الثقافة المحلية والقضايا الوطنية والاجتماعية، فانبروا لمحاربتها لهذا السبب؟ وإن كان الأمر كذلك، فمن أين أتو بهذه القناعة؟
اللافت هنا أن النقاش حول هذه المسألة غالباً ما يضع الممارسات الحداثية في مواجهة مع ما يُطلقون عليه "التغريب" أي التأثر أو السير خلف الاتجاهات الغربية من دون وعي. يتمادى البعض في قناعاتهم تلك، حتى أنهم يتعاملون مع هذه الممارسات الفنية كنبت شيطاني، ودليل على الانقياد الأعمى للغرب، وهذا أمر مثير للدهشة في الحقيقة، فإذا ما أنعمنا النظر جيداً سندرك بلا شك من كان يسير وراء الغرب بعيون مُغمضة، ومن يحاول اليوم إستعادة الهوية والمبادرة بالفعل.
الدفاع عن الهوية
إن اتهام شريحة من الفنانين بأنهم فاقدون للهوية أو مُنقادون وراء أفكار ليس لها علاقة بقضاياهم وهويتهم، لمجرد تبنيهم لممارسات فنية بعينها هو أمر بالغ القسوة والغرابة. ولا نعرف على وجه التحديد من أين تولدت هذه القناعة عند هؤلاء، ممن ينصّبون أنفسهم حماة للهوية؟ وما هي هذه القيم الراسخة التي يدافعون عنها ويرفعون لواءها في أي نقاش يتعلق بالممارسات الفنية؟ هل يُقصد بها استخدام العناصر والمفردات والرموز في العمل الفني، أم هي تعني وجوب الحفاظ على أساليب التعبير التقليدية؟ أهذه هي القيم المتوارثة والراسخة المقصودة؟ وإذا ما كانوا يشيرون إلى الأفكار والقضايا والتساؤلات التي تطرحها تلك الأعمال المعاصرة، فمن أين خَلُص هؤلاء بأنها أعمال وممارسات خالية من الطرح الحقيقي ومُنفصلة عن الواقع والقضايا الوطنية؟ وكأن على الفنان كي يكون صاحب قضية وطنية أن يعكف على استلهام المفردات والعناصر المحلية في أعماله، أو ربما يتحتم عليه التعبير عن إنجازات الدولة ومشاريعها القومية، كما كان يحدث في ستينيات القرن الماضي، حين تماهى الفنانون مع الشعارات التي رفعتها السلطة وقتها.

لوحة للرسام السوري فاتح المدرس (موقع الرسام)
يحق لنا إذاً أن نتساءل: هل هذه الهوية حقاً قد زرعها الرعيل الأول من الفنانين ومن تبعهم، ثم جاءت هذه الممارسات لتقتلعها من جذورها؟ وهل التمسك بالممارسات التقليدية هو تمسك بالهوية؟ وهل تُعبر هذه الممارسات الحداثية عن الهوية بالفعل؟ أولم تكن هذه الممارسات الحداثية في مُجملها مجرد انعكاس لحركة الفن الغربي؟ تساؤلات كثيرة قد لا نجد لها إجابة شافية في الكثير من الكتابات التي نطالعها بين الحين والآخر، منشورة على هيئة مقالات أو متابعات صحافية، أو حتى آراء عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اللافت ألا تخلو معظم الكتابات التي تتناول رواد الحداثة المصرية والعربية من ذكر المدارس والأساليب التي اتبعوها، من انطباعية إلى سريالية وتعبيرية، وغيرها من المدارس والمصطلحات التي نُحتت في الغرب، ولم يكن لنا يد في نشأتها أو ظهورها، في الوقت الذي يهاجم فيه أصحاب هذه الكتابات ممارسات بعينها ويتهمونها بالتبعية للغرب.
فرصة متساوية
بعيداً عن الدخول في تفاصيل ومفهوم الهوية، فالممارسات المعاصرة لم تقتلع الهوية ولن تقتلعها أبداً، بل هي تمثل فرصة مواتية لفهمها واكتشافها، أو تعريفها من دون شعارات أو مماحكة، والتعامل معها كحالة نابضة غير جامدة أو مُحنّطة. إن الممارسات المعاصرة تقدم لنا وكافة شعوب الأرض فُرصة مُتساوية للمشاركة والتفاعل والإبداع والإضافة الحقيقية، وليس مجرد السير وراء المُنجز الغربي خطوة بخطوة. هذه الممارسات المعاصرة قد تشكلت على مدى العقود الماضية بجهود فنانين من كافة أنحاء العالم، فلم يعد المُمارسون للفن في حاجة للجلوس وانتظار ما يجود به الغرب من أساليب أو ممارسات كما كان يحدث. نعم هناك فنانون مصطنعون، لكنهم متواجدون في كل زمان ومكان، وعلينا أن نفرق بين التجارب الجادة والمُصطنعة أو غير الصادقة. إنه لأمر بالغ الغرابة حقاً، حين نتهم البعض بأنهم آداة في يد الغرب لمجرد أنهم يحاولون الخروج عن الأطر التي وضعها الغرب.
هناك جيل يحاول تلمس طريقه بالفعل، مُشكلاً تجربته الخاصة بمعزل عن أي تأثيرات أخرى، جيل يسعي للمُساهمة والمبادرة الفاعلة لتغيير المشهد الفني المُصطنع، وهناك في المُقابل أيضاً سعي لتكريس هذا المشهد والحفاظ عليه اعتماداً على شعارات وحجج واهية. هذه الاتهامات والآراء المُحبطة لا تزيد المشهد إلا إرباكاً، وهي تُساهم بلا شك في زيادة الالتباس حول مفهوم الفن والممارسة الفنية، ليس عند الأجيال الجديدة من الفنانين فقط بل والمتلقين أيضاً. علينا أن ندفع هؤلاء الفنانين ونطالبهم بألا يكفوا عن الإبداع، وأن يمارسوا فنهم بكل حرية، أن يرسموا لوحات أو يصنعوا نحتاً، وإن أرادو تجاوز الحدود والقواعد فليتجاوزوها، فلا قداسة في الفن، ولا خطوط حمراء داخل إطار التعبير البصري، فالدائرة اليوم تتسع للجميع وتخلع عن الممارسة الفنية ثوب التبعية والانقياد.












































