إضاءة على كتاب «الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن» لفهمي الكتوت: تداعيات اقتصاد مأزوم
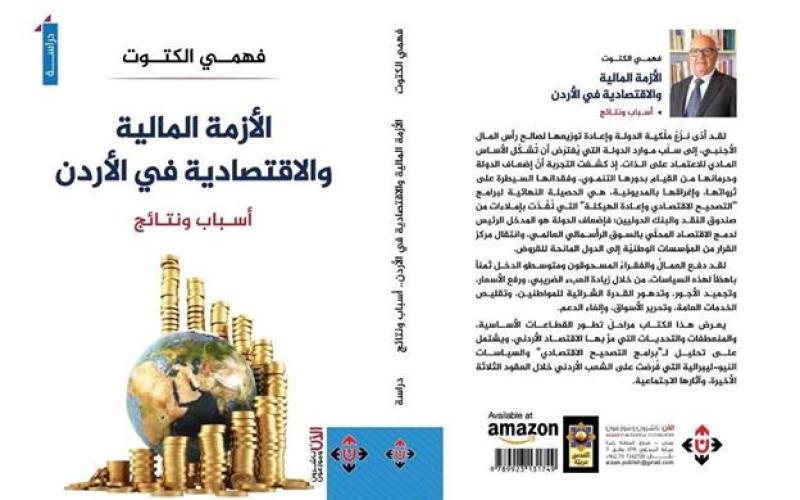
يغطي كتاب «الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن» لفهمي الكتوت حالة الاقتصاد الأردني منذ عام 1967 وحتى عام 2018. يقع الكتاب في أربعة فصول هي: «الاقتصاد الأردني 1967-1989»، «برامج السياسات الليبرالية»، «التنمية الاقتصادية» و«السياسات المالية». هو الجزء الثاني من سلسلة للمشهد الاقتصادي الأردني، وهناك جزء ثالث يصدر قريبًا. يمسح الكتاب -ضمن الفترة التي يعلن عنها- تداعيات حرب حزيران اقتصاديًا، وحالة الاقتصاد الأردني حتى عام الأزمة 1989، وبرامج «التصحيح الاقتصادي» التي خضع لها الأردن، وشكل التنمية الاقتصادية ودور قطاعي الزراعة والصناعة في الاقتصاد الأردني، والسياسات المالية العامة بما فيها موزانات الدولة منذ 1968 وحتى 2018.
لم يكن الاقتصاد الأردني يومًا من الأيام اقتصادًا منتجًا موجهًا نحو الاعتماد على الذات، والمشاريع المولدة للدخل والوظائف. فهو منذ التأسيس يقوم في جزء من نفقاته العامة على مساعدات من بريطانيا، ولاحقًا عبر سياسة ملء الفراغ على مساعدات أميركا. وهو منذ أول قرض عام 1949 من بريطانيا، وبلغ مليون جنية إسترليني، يعتمد على القروض إلى جانب المساعدات، ومنذ ارتفاع النفط عام 1973، وبدء الانتعاش الاقتصادي في دول الخليج، صار يعتمد على المساعدات والقروض وتحويلات المغتربين والضرائب. بذا، فهو اقتصاد ولد مشوهًا، ولم تحاول الدولة إنقاذه عبر محاولة جدية لا في الوضع الطبيعي، ولا في الأزمات التي هي بمثابة نتيجة لأسباب جذرية وبنيوية قبلها، وكان آخرها أزمة كورونا.
يلقي هذه المقال إضاءة على واقع الاقتصاد الأردني اعتمادًا على كتاب فهمي الكتوت بشكل كبير، وورقة بعنون The IMF and the World Bank in Jordan: A case of over optimism and elusive growth، إضافة إلى بعض من إحصاءات وزارة المالية والبنك المركزي.
الاقتصاد الأردني 1967-1989
لقد كان لحرب حزيران أثر بالغ على الاقتصاد الأردني نتيجة سقوط الضفة الغربية في يد الاحتلال الصهيوني، ونزوح مئات الآلاف إلى الضفة الشرقية، والعمليات العسكرية التي تلت الحرب على الحدود في مواجهة الاحتلال، مما سبب حالة انكماش حاد لم تبدأ بالتعافي إلا مع ارتفاع النفط عام 1973 نتيجة توقف الدول العربية عن تصديره إلى أميركا وتخفيض الإنتاج بنسبة 25%. هكذا بدأ انتعاش اقتصادي في دول الخليج، فباتت تحتل الصدارة في الناتج الإجمالي للدول العربية مختطفة المرتبة الأولى من مصر التي لازمتها خلال الستينيات وأوائل السبعينيات، مما ساهم في ارتفاع مستوى تدفق المساعدات العربية إلى الأردن، وزيادة صادراتها بعد توسع الأسواق العربية أمامها، واستقطاب العمالة الأردنية إلى هناك، مما أدى إلى نمو حوالات المغتربين، فمع بداية الثمانينيات كان ما يقرب من ثلث الأيدي العاملة الأردنية في الخليج، حيث بلغ معدل حوالاتها 918 مليون دولار أمريكي كان يستثمر أغلبها في شراء الأراضي والمساكن. هذا النمو الاقتصادي، رافقه توسع في النفقات التي قفزت من 139 عام 1974 إلى 675 مليون دينار عام 1982، ولم تبلغ مساهمة الإيرادات المحلية إلا 46% من النفقات، فيما غطت المساعدات 34.5%، والقروض 19.5%.
نتيجة لذلك، ارتفعت نسب التضخم وتكاليف المعيشة مما تسبب في تآكل الأجور، وانخفاض القدرة الشرائية للدينار بنسب كبيرة من 110% عام 1973 إلى 165% عام 1976، فيما لم يتم استغلال هذا «الازدهار»، حسب تعبير وزارة التخطيط، خير استغلال في تنمية القطاعين الأساسيين، وهما الزراعة والصناعة. على العكس من ذلك، تراجع القطاع الزراعي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1971 إلى 6% عام 1982، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب دور الدولة الواضح عن تطوير هذا القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي، وتوظيف أبناء المزارعين في الجيش والأمن والقطاع العام، مما جعلهم يتخلون عن أراضيهم الزراعية التي لم تعد ملبية لكفاف يومهم. وقد انعكس هذا التراجع في ارتفاع مستوردات الأردن للمواد الغذائية والمواد المصنعة من 47.12 عام 1972 إلى 383.66 مليون دينار عام 1982. أما قطاع الصناعة فقد ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 11% عام 1973 إلى 19.2% عام 1982، غير أنه كان في الصناعات التحويلية خاصة تلك التي تتعلق بتجميع القطع المستوردة، ولم يدم هذا التحسن طويلًا إذ سرعان ما تراجع بعد عام 1984.
ومع أن الصادرات نمت عام 1982 بنسبة 430% مقارنة بعام 1974، إلا أن المستوردات كانت بنسبة 630% لنفس الفترة، مما فاقم عجز الميزان التجاري ليصبح 55.5% عام 1980 مقابل 37.6% عام 1972، وتراجع ميزان المدفوعات. الأنكى من ذلك أن معدل تصدير المواد الخام بلغ 38% من مجمل صادرات السنوات المذكورة (1974-1982)، وكان الأجدى استثمارها كمدخلات إنتاج في الصناعة المحلية تدر قيمة مضافة تمكننا من اسثمارها لاحقًا في مزيد من النفقات الرأسمالية المولدة للنمو المترافق مع التنمية.
وقد استمرت الدولة في نفس النهج الذي انعكس في خطتها الخمسية الثانية (1981-1985)، رغم بدء ظهور بوادر التباطؤ الاقتصادي. فمع بداية الثمانينيات تراجعت أسعار النفط، مما انعكس سلبًا على المساعدات العربية، وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج، وحركة التصدير. كما كان للحرب العراقية الإيرانية دور في تراجع المساعدات العربية التي اتجهت نحو دعم العراق عكسريًا، فيما حاولت القيادة العراقية أن تدعم الأردن من خلال الاعتماد في مستورداتها على خليج العقبة، وفتح سوقها أمام الصادرات الأردنية مما ساهم في تطوير الصناعات التحويلية، إذ أنشئت صناعات تعمتد على احتياجات السوق العراقي، إلا أن ذلك لم يعوض النقص في المساعدات، مما ساهم في اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل النفقات الجارية، وفي خفض الإنفاق الرأسمالي.
بذا، مع نهاية عام 1988 انفجرت الأزمة الاقتصادية، فنضبت احتياطيات البنك المركزي، وتوقفت الحكومة عن دفع مستحقات الدين الخارجي، وانهار سعر صرف الدينار من 2.96 دولار عام 1987 إلى 1.74 عام 1989، إلى 1.51 عام 1990. لم تفلح قبلها بشهور بعض محاولات الحيلولة دون وقوع الأزمة التي تمثلت بسن قانون جديد لتشجيع الاستثمار، وبعض السياسات المالية والنقدية التي كان أبرزها تعويم سعر صرف الدينار، والتخلي عن ربطه بالدولار الأمريكي الذي استمر العمل به منذ منتصف السبعينيات. كانت هذه المحاولات بضغط من صندوق النقد والبنك الدوليين كشرط للحصول على قرض، وهذا الضغط الذي تكلل بالنجاح كان موجودًا منذ منتصف الثمانينيات لتحرير القطاع المالي، وسعر الصرف، في الطريق إلى إيقاع الأردن في قبضة هاتين المؤسستين الماليتين.
لقد تسببت الأزمة في تراجع النمو الاقتصادي ليصبح سالبًا في معظم القطاعات، وتفاقمِ عجز الموازنة العامة، وارتفاعٍ لا مثيل له في الأسعار، حيث بلغت نسبة التضخم 25.5% عام 1989 مقابل 6.6% عام 1988، وتفاقم الدين العام مع انهيار سعر صرف الدينار ليصبح 5.8182 مليار دينار نهاية 1989، حيث الدين الخارجي بواقع 4.8232 مليار دينار والداخلي بواقع 995 مليون دينار. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16.8% عام 1989، و18.8% عام 1990. كان ذلك بمثابة شرارة لهبة نيسان التي التف عليها النظام السياسي بفتح الحياة السياسية، وإنهاء مرحلة الأحكام العرفية التي استمرت منذ إسقاط الحكومة المنتخبة الوحيدة في تاريخ الأردن، حكومة سليمان النابلسي، عام 1957. ولكي تخرج الأردن من الأزمة لم تجد أمامها سوى صندوق النقد الدولي.
برامج السياسات الليبرالية
في أعقاب الأزمة المزدوجة المالية والمصرفية لجأ الأردن الرسمي إلى صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة الدين العام، والحصول على قروض جديدة لتمويل النفقات وتغطية المستوردات. نتيجة لذلك، كان على الأردن أن يخضع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين حتى يتمكن من السير في خدمة الديون، فتم تطبيق حزمة من الإجراءات النيوليبرالية الانكماشية التي أرهقت الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وركزت المال في أيدي قلة من المتنفعين، وخلقت طبقة طفيلية تلعب دور الوكيل المحلي لدى جهات المركز الرأسمالي، وأنهكت الاقتصاد الذي ولد مشوهًا وسدّت أفقه، وعممت ثقافة الاستهلاك بشكل أكبر مما مضى، فتم تحرير الأسعار، وزيادة الضرائب غير المباشرة، وإلغاء الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وتحرير التجارة الخارجية، وإلغاء الحماية الجمركية لتسهيل انسياب سلع الدول التي تساهم في المؤسسات المالية الدولية والجهات المقرضة، وتخفيض التعريفة الجمركية، وخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات، وانسحاب الدولة من أداء دورها الاجتماعي، والسير في خفض الإنفاق الرأسمالي، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
هكذا، خضع الاقتصاد إلى ستة برامج «تصحيح اقتصادي» للأعوام 1989-2004. ثلاثة برامج «اتفاقيات استعداد ائتماني»، وثلاثة برامج «تسهيل ممدد»، لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ثم استؤنفت علاقة التبعية للصندوق من جديد عام 2012 على ثلاثة برامج حتى الآن، آخرها يستمر حتى العام 2022. كما تلقى الأردن ثمانية قروض من البنك الدولي لفترة 1989-2004 تتعلق بـ «إصلاح» القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وسياسات الصناعة والتجارة، وتمويل التنمية و«الإصلاح» الاقتصادي، إضافة إلى قروض لاحقة أخرى. ومن ينظر في التناقض بين أهداف هذه البرامج، والنتائج الحقيقية لها، يدرك بأن الصندوق لا يهمه خفض قيمة الدين، بل أن تظل الدولة خادمًا أبديًا لفوائد هذا الدين، وسوقًا لبضائع الدول الممولة للجهات المقرضة.
لكن لكي يتحقق ذلك كان لا بد من خفض القيود على المستوردات، وتحرير التجارة الخارجية، وسحب دور الدولة من التحكم في الأسعار. هكذا خفض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية من 70% عام 1993، إلى 35% عام 1999، و30% عام 2004، فيما انخفض المعدل العام للتعريفة الجمركية من 35% عام 1978، إلى 25% عام 1999، إلى 13.5% عام 2000. ودخل الأردن في منظمة التجارة العالمية، ووقع اتفاقيات للتجارة الحرة، ثنائية وجماعية، منها اتفاقية مع أميركا عام 2001، وأخرى مع دول أوربا، وغيرها، وكلها تعفي البضائع الواردة من الرسوم والضرائب الأخرى، أو من الرسوم الجمركية وحدها، أو تخفضها. هذا جعل الأردن سوقًا للبضائع الأجنبية التي قضت على المنتج المحلي الوطني نتيجة ارتفاع سعره بسبب الضرائب وتكلفة الطاقة، مما ساهم في تحطيم أية قاعدة للتوجه نحو الإنتاج، ووضع الاقتصاد تحت رحمة التجارة وحدها بقطبيها الوكيل المحلي والمورد الخارجي، وشكل طبقة رأسمالية عميلة باتت في مركز صانع القرار تحل وتربط وتحدد مصير الملايين من المواطنين.
نتيجة للأزمة الاقتصادية حقق الأردن نموًا سالبًا عام 1989، وظل أقل من 2% حتى عام 1992. فيما سار بمتوسط نمو بلغ 4% خلال الفترة 1994-2000. كان لهذا أثرًا كبيرًا في الإشادة به من المؤسسات الدولية، وكأنه يسير في الاتجاه الصحيح. غير أن عوامل التحسن «الرقمية» هذه -فضلًا عن أنها لم تسهم في تحسين الاقتصاد بشكل بنيوي، ولم تعزز دور القطاعات الإنتاجية، ولم تخفض معدلات الفقر بل رفعتها- لم يكن لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين علاقة بها، إذ أنها تخضع لعوامل إقليمية محيطة كان لها أثر مباشر وجوهري. فقد نتج عن حرب الخليج عودة نحو 300 ألف أردني مع مدخراتهم، إضافة إلى انتقال مستثمرين عراقيين وعرب، ضخوا أموالهم وحركوا عجلة الاقتصاد، لكنه ضخ استهلاكي في أغلبه استهدف الأراضي والعقار، مما خلق فقاعة في هذين القطاعين أدى إلى زيادة النمو في قطاع الإنشاءات بنسبة 10.5% و15.9% خلال الأعوام 1991 و1992. وبعد انحسار هذه الفقاعة لوحظ تراجع معدلات النمو في النصف الثاني من التسعينيات. إضافة إلى ذلك، ساهم في طفرة النمو هذه شطب 72.19 مليون دولار من ديون المملكة المتحدة عام 1994، وقرابة 700.4 مليون دولار من ديون أميركا في الأعوام 1994، 1995، 1997، نتيجة لتحول السياسة الخارجية إلى النأي عن العراق بعد حرب الخليج، وكمكافأة على توقيع معاهدة وادي عربة.
من ناحية أخرى، كان لحرب العراق عام 2003 يد في تحقيق نمو بلغ متوسطه نحو 7.5% للأعوام 2001-2008، إضافة إلى عائدات خصخصة شركات القطاع العام التي حدثت عبر مجزرة تشريعية بعد حل مجلس النواب في حزيران/2001 بحجة الحرب على الإرهاب، فمرر ما يزيد على 211 قانونًا بمراسيم ملكية استهدفت الخصخصة، وتشجيع الاستثمار، والجمارك، وتقدير القيمة الجمركية، والضرائب وغيرها، فخصخصت 34 شركة عامة سريعًا وبصفقات مريبة يعتورها شبهات فساد. مجددًا، اتجهت أغلب استثمارات العراقيين القادمين نحو العقار، ولم تستثمر في مشاريع إنتاجية مولدة للدخل. فيما وجهت عائدات خصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتي بيعت بأثمان بخسة بلغ مجموعها 1.7167 مليار دينار، حسب نشرة وزارة المالية عام 2015، نحو تسديد فوائد الديون، والتوسع في الإنفاق الجاري، ولم تستثمر في فتح مشاريع رأسمالية تخفف من الاعتماد على القروض، ومن حدة الفقر والبطالة.
بهذا، فإن زيادة النمو خلال سنوات محدودة لا علاقة له ببرامج الصندوق. وعند التدقيق في القطاعات التي حققت النمو تجد أنها قطاعي التجارة الخارجية والإنشاءات. أما قطاع التجارة الخارجية فهو نابع من إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي زادت صادراتها، لكنها تسببت في زيادة المستوردات، مما فاقم عجز الميزان التجاري. وهذه المناطق لا يجني الأردن فائدة نوعية منها، فهي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج، ومعفاة من الرسوم والضرائب، وعمالتها في معظمها من دول شرق آسيا، فيما تحجز الوظائف الكبرى ذات الدخل المجدي لصالح من يحملون جنسية أصحاب المصانع والشركات، أما الأردنيون فيحصلون على أقل نسبة من الوظائف ذات الرواتب التي لا تتعدى الحد الأدنى من الأجور، هذا عدا عن أن هذه المناطق هي مشروع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويشترط فيها أن تستورد ما لا يقل عن 8% من مدخلات الإنتاج الصهيونية.
وبما يخص النمو، فقد كان له آثار كارثية على عموم المواطنين أبناء الشرائح المتوسطة والفقيرة، وكان مجرد رقم لم يترافق مع التنمية والتوزيع العادل للثروة، مما زاد من معدلات الفقر والبطالة. فرفع الدعم عن المواد الغذائية، وسن قانون المبيعات عام 1994، لترتفع بذلك الضريبة من 7% إلى 10% ثم إلى 16% عام 2004، وفرض الضرائب الخاصة على المحروقات والكهرباء، زاد من اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية فارتفعت نسبتها إلى 70% من الإيرادات المحلية. هذه الإيرادات لم تستثمر في خفض عجز الموازنة، ولا في زيادة خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بل وجهت نحو التوسع في النفقات الجارية، خاصة العسكرية منها. وقد نجم عن هذا التوسع في الإنفاق، الممول بالقروض والضرائب، ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى تآكل الأجور وارتفاع الأسعار. ثم ها نحن في عام 2020، وقد ارتفعت المديونية العامة من نحو 5.82 مليار دينار عام 1989 إلى 32.06 مليار دينار، نعاني من ركود يضرب منذ عام 2010 استجابة للأزمة التي انفجرت في أميركا عام 2008 وطالت كل العالم، ثم جاءت جائحة كورونا فأدخلتنا في طور التأزيم.
التنمية الاقتصادية
حين نتحدث عن التنمية الاقتصادية، فإننا نعني ضرورة وجود اقتصاد يعتمد على قاعدة إنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة بشكل أساسي، على أن تكون الصناعة معتمدة أكثر الاعتماد على الموارد الطبيعية في الأردن بدلًا من تصديرها على شكل مواد خام لا تحقق ربحًا مجديًا، وأن تكون الزراعة موجهة داخليًا نحو تحقيق الأمن الغذائي. بل من المهم أن يتشابك القطاعان معًا في الصناعة الزراعية أيضًا. وكل هذا ينبغي أن يتحقق بوجود إرادة سياسية حقيقية لذلك، وتخطيط يعيد هيكلة الاقتصاد بشكل بنيوي، ويحل مشكلة الطاقة التي قضت على تنافسية المنتج الأردني حتى في السوق المحلي، وعبر فرض نظام ضريبي تصاعدي يخفف العبء على القطاعات المنتجة، ويزيده على قطاعات الخدمات والمصارف والتأمين. من المهم في هذا السياق عقد تحالفات اقتصادية عربية للتبادل وتعويض النقص في المنتجات، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بخبرات خارجية لا تؤثر على القرار الوطني، مع أهمية وجود بحث علمي موجه نحو تطوير ما لدينا من معطيات في الاقتصاد وإدخال وسائل التكنولوجيا.
إن لم يكن لدينا اقتصاد يوزع الثروة بشكل عادل ومعقول بين أفراد المجتمع، ويخفف من حدة الفقر والبطالة، ويسعى دائمًا نحو مزيد من الازدهار، فسوف نظل ندور في حلقة من الأرقام الجوفاء التي لا معنى لها. وإن لم تتولَّ الدولة فتح المشاريع الإنمائية التي تزيد من حصتها في الإنتاج، ومن نفقاتها الرأسمالية التي تدر العوائد وتولد الوظائف الإبداعية المفيدة وتحرك السوق، فسوف نظل نرزح تحت رحمة القطاع الخاص وشركات المركز الرأسمالي. التنمية الاقتصادية لا تعني بأي شكل من الأشكال أن تكون سهل التأثر بالصدمات الخارجية، وأن تربط نفسك باقتصادات الدول الكبرى. لا أن تعتمد على القروض، والمساعدات، وتحويلات المغتربين، والضرائب! بل أن تنأى بنفسك عن كل ذلك نحو اقتصاد همه داخلي أكثر مما هو خارجي. غير أن الناظر في الاقتصاد الأردني، يجد أنه يعتمد على قطاع الخدمات بنحو 67% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن قانون الضريبة وحد العبء الضريبي بين قطاعي الصناعة والزراعة وقطاع التجارة، بل وفرض ضريبة على قطاع الزراعة لأول مرة عام 2018، مما حول المستثمرين إلى قطاع التجارة الذي يمتاز بمخاطر أقل وربح سريع.
ينقسم قطاع الصناعة في الأردن إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: صناعات تحويلية، صناعات استخراجية، وإنتاج الكهرباء والمياه. يسهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 18% من مجموع العاملين، ويساهم بنحو 90% من الصادرات. غير أن الدولة تخلت عن أهم مقدراتها الصناعية وخصخصتها استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي؛ الفوسفات والبوتاس والإسمنت وغيرها. لقد زار البنك الدولي الأردن مبكرًا عام 1955، وكتب تقريرًا شاملًا خلص فيه إلى أن تطوير الاقتصاد في الأردن يمر بطريق صعب «بسبب محدودية المواد الخام الأولية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وصغر السوق المحلي الاستهلاكي»، وهكذا حصرت الصناعة بعدد محدود من المنشآت الصناعية، وظل الأردن معتمدًا على استيراد مستلزماته السلعية من الخارج، وبقي رهنًا للمساعدات الأمريكية والقروض مقابل التبعية السياسية، خاصة بحكم موقعه الجيوسياسي. والآن يواجه قطاع الصناعات التحويلية منافسة حادة في الأسواق، إذ أن هناك دول تدعم صادراتها نقديًا، مثل تركيا، بينما يفرض الأردن ضريبة مبيعات قدرها 16% على مدخلات الإنتاج، وضرائب خاصة على المحروقات والكهرباء.
أما قطاع الزراعة فيساهم بنسبة ضئيلة قدرها 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 11% من الصادرات، 92% منها تذهب إلى الأسواق العربية خاصة الإمارات والكويت وقطر وسوريا. لكن ولأهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، ولأننا في منطقة ملتهبة تاريخيًا، ولأن العالم يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء بسبب الاحتباس الحراري والتصحر، فإن الزراعة هي أهم قطاعات التنمية الاقتصادية التي بنبغي الاستثمار فيها. غير أن السلطة تهدم ما يبنى. فقد كان للقطاع الزراعي أهمية كبرى في رفد الاقتصاد الوطني منتصف القرن الماضي، حيث ساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تراجع إلى 14.4% عام 1971، وواصل تراجعه حتى وصل إلى 3.4%. بالنسبة للملكيات، حسب التعداد الزراعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2017، فإن 88% من المزارعين يملكون 19% من مساحة الحيازات الزراعية، فيما 1.8% يملكون 56% منها. ويشكل الإنتاج الحيواني حوالي 53% من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تربية الدواجن تأخذ النصيب الأكبر من هذا الإنتاج وتلبي حوالي 87% من احتياجات السوق، وتربية الأبقار تأتي في المرتبة الثانية وتلبي 75% من الاحتياجات المحلية للحليب الطازج، بينما هناك شح في الماعز والضأن، إذ تحقق 38% من الاكتفاء الذاتي. هذا التراجع في قطاع الزراعة يعود لعدة أسباب منها: الظروف المناخية، ومحدودية الأراضي الخصبة، وشح المياه، وتفتت الملكية، والزحف السكاني. فيما أهمها عدم التفات الدولة لهذا القطاع، وقلة الدعم الموجه له ماديًا وتقنيًا، تنفيذًا لإملاءت صندوق النقد والبنك الدوليين، وغياب استخدام أقل وسائل التكنولوجيا التي تعظم الإنتاج، وتوظيف أبناء المزارعين في الجيش والأمن والقطاع العام، لأن الراتب أجدى لهم من عوائد العمل الزراعي!
السياسات المالية
تعكس السياسات المالية للدولة نظرتها للطبقات الاجتماعية المختلفة، من خلال مصادر الإيرادات وطرق توزيع النفقات، وهل تراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة أم لا. ما يحدث في الأردن هو وجود سياسة نيوليبرالية تركز الثروة في يد قلة طفيلية متنفعة، ومرتهنة للخارج. أما النظر في موازنات الدولة عبر خمسة عقود مضت فيفضي إلى أنها تعتمد بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة، إضافة إلى الضرائب المباشرة، والمساعدات، والقروض.
لقد قفزت الموازنة من 79 مليون دينار عام 1968 إلى 10.5 مليار دينار عام 2018. كما ازداد الدين العام من 5.82 عام 1989 إلى 32.06 مليار دينار عام 2020، ليشكل قرابة 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي. علمًا أن الدين الداخلي ارتفع فجأة من 3.695 عام 2007 إلى 5.754 مليار دينار عام 2008، وذلك بعد بيع ميناء العقبة وتحويل عائداته لإعادة شراء جانب من الدين الخارجي لنادي باريس، فلجأت الحكومة حينها إلى مزيد من الاقتراض الداخلي لتغطية النفقات الجارية، مما جعل الدين الداخلي يتجاوز الخارجي، وظل على هذه الحال إلى يومنا هذا، إذ تبلغ نسبته قرابة 60% من مجموع الدين العام. كما أن الدين العام بشقيه قفز من 12.591 إلى 24.867 مليار دينار في فترة 2011-2015 بسبب سوء إدارة ملف الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري، والتأخر في إنشاء ميناء الغاز المسال.
ارتفعت أيضًا نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات المحلية من 48% عام 1989، إلى 62% عام 2000، إلى 70% عام 2010، ثم تراجعت إلى 65% عام 2018، وذلك بسبب الركود الاقتصادي، إذ كلما ازداد العبء الضريبي الناجم عن رفع الضرائب غير المباشرة انخفضت نسبة العائدات بسبب تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولجوئها إلى ضبط الإنفاق حتى على السلع والخدمات الضرورية التي تحتاجها.
أما النفقات الرأسمالية، التي تحرك السوق وتولد الدخل والوظائف، وتقلل من حدة الفقر والبطالة، فقد انخفضت نسبتها إلى النفقات العامة من 32% عام 1989، إلى 17% عام 2000، و17% عام 2010، و11% عام 2018، مقابل ارتفاع نسب النفقات الجارية. كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 13% من النفقات، لتتجاوز بذلك نسبة الإنفاق الرأسمالي. فيما حافظت النفقات العسكرية على نسب ثابتة تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي (بين 8.5% إلى 11%)، وهي من النسب الأكبر عالميًا. وتحصل وزارتا الصحة والتعليم على نسب ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 3.4% عام 1989، و5.7% عام 2000، و5.5% عام 2010، و5.1% عام 2018. وبالنظر إلى نصيب خمس من أهم الوزارات، من موازنة عام 2018 (التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة، والعمل) نجد أنها 23% من النفقات الجارية فقط، مما يعكس انسحاب الدولة من أداء دورها الاجتماعي، وتردي التعليم والصحة، وعدم الالتفات إلى البنية التحتية، وإلى الزراعة كقطاع جوهري في الاقتصاد.
إن السياسات النيوليبرالية، والتبعية السياسية، ووصفات صندوق النقد الدولي، أزمت الاقتصاد الوطني، وأنهكت حياة المواطنين، وتسببت في تعميق الخراب، وجعلت الدولة خادمًا أبديًا للديون، ومنفذًا نجيبًا للإملاءات، وسوقًا للبضائع المستوردة ما نستطيع إنتاجه منها وما لا نستطيع.
خاتمة
لقد عمق النظام الرأسمالي بنسخته الليبرالية الجديدة من الأزمات، وأثر على ثقافة الإنتاج، فباتت دورة الأزمات سريعة ومتصلة ومتداخلة مع بعضها، وما اليوم إلا خير مثال على ذلك؛ فنحن ما زلنا نعيش ارتدادت أزمة العام 2008، ونقع في أزمة جديدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. الرأسمالية المالية، والمضاربات، والبورصات، والبنوك، اكتسحت العالم، وكبلت الدول بالديون، واحتلتها «عن بعد». إن وضعًا مثل هذا يستحق التأمل وإعادة التفكير. لا ينبغي للدول أن تربط نفسها بالصدمات الخارجية. عليها أن ترسم خططًا استراتيجية تخفف من حدة تأثرها. وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية أولًا، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذري يكون عماده تخفيض الاعتماد على المستوردات، وتقوية القطاعات الداخلية المنتجة، وتحقيق الأمن الغذائي.
نحن في الأردن نمر بأزمة كبرى، واقتصادنا يعتمد في جله على الضرائب والمساعدات والقروض وتحويلات المغتربين، فيما يحتل قطاع الخدمات بكافة أشكاله 67% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهمل قطاعات الزراعة والصناعة، ويهمل التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل العام. تكبلنا الديون، والسلطة السياسية العميلة التابعة. النهج السياسي والاقتصادي القائم أوصلنا إلى ما نحن فيه، وعمق ضعفنا وفككنا اجتماعيًا. إنها أزمة كبرى علينا أن نخفف من حدتها اليوم قبل الغد، وألا نبقى صامتين.












































